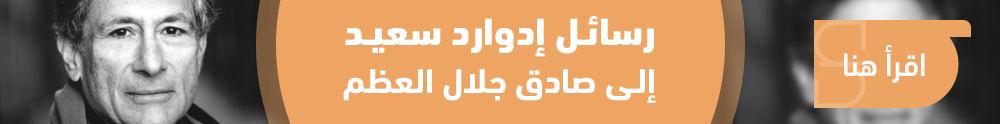"كنت في شدة الجوع الهائلة، فتناولت قطعة خشب من الطريق ألوكها في فمي. وقد أفادتني بالفعل، فكيف أني لم أفكر فيها من قبل".
- رواية الجوع لـ كنوت هامسون
الغذاء ليس كمواد التجميل، ولا هو كالمخدرات التي يتورط فيها الفرد عادةً، بإرادته بل ينهض الغذاء شرطًا أساسيًا للبقاء على قيد الحياة مثله مثل الماء والهواء وهذا يعني أن التحكم فيه من فئة أو سلطة أو نظام هو اعتداء على الحق في الحياة ومحاولة احتكارها عبر احتكاره. وما دام الغذاء كما يسجل كل من فرانسيس مورلاييه وجوزيف كولينز في كتابيهما "صناعة الجوع: خرافة الندرة": "يشترى ويباع مثل أية سلعة أخرى، وما دامت نسبة كبيرة من البشر أفقر من أن تشتري ما تحتاجه من غذاء فسوف تظل المشكلة الرئيسية أمام الاقتصاديين الزراعيين هي تهديد الفائض وليس الندرة".
تشتغل السياسة في العالم كله على إنتاج الجوعى وصناعة الجوع فهو الرأسمال الضروري للبقاء، حتى إن التونسيين يرددون بين فينة وأخرى مقولة غير مؤكدة للزعيم الحبيب بورقيبة، وقع تداولها كثيرًا زمن أحداث الثورة على ألسنة المحللين: "الشعب التونسي صعب فلا تشبعه كل الشبع ولا تجوعه كل الجوع فإنك إن جوعته انقلب عليك". وكانوا يقصدون بذلك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي قامت الثورة ضده بسبب سياسة التجويع واخفاقات التنمية. غير أن حكومات ما بعد الثورة لم تنجح في تغيير الأوضاع الاجتماعية بل صارت أسوأ وارتفع عدد الفقراء.
تشتغل السياسة في العالم كله على إنتاج الجوعى وصناعة الجوع فهو الرأسمال الضروري للبقاء
فما الذي سيجعل الناس في مثل هذه الظروف يستجيبون لقرارات السلطة بالبقاء في بيوتهم، تلك السلطة نفسها التي جعلت من الغذاء وعملية التحكم فيه سبلها في الدعاية لها ولحكمها؟ وهي نفس السلطة التي تحرم هذا الفرد الجائع من تلبية حاجاته الضرورية: الغذاء؟
الغداء والسياسة
ارتبطت الانتفاضات ببعض البلدان في العالم، ومنها تونس، بالغذاء. ففي الثمانينيات ثار التونسيون على السلطة وخرجوا إلى الشارع معرضين صدورهم إلى الرصاص بسبب غلاء الخبز حتى سميت تلك الانتفاضة بـ"أحداث الخبز"، وكان من بين الشهداء الشاعر الفاضل ساسي، وبعد سقوط العديد من القتلى في ذلك الخميس الأسود من كانون الثاني/يناير 1984، حيث قارب المائة شهيد، أصدر الرئيس الحبيب بورقيبة قرارًا بالتراجع عن كل الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة والعودة إلى الأسعار القديمة، وخاصة ما تعلق بالخبز. وقد ظلت تلك الانتفاضة وما انجر عنها من قتل وعنف نقطة سوداء في تاريخ بورقيبة السياسي، وفي نفس الوقت دليل على حنكته السياسية عندما تنصل من تلك الزيادات وضحى ببعض السياسيين لإنقاذ سلطته.
اقرأ/ي أيضًا: "الموت الأسود" في أعمال كتاب ومؤرخي الشرق
عندما انتفض التونسيون سنة 2011 لإسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، رفعوا شعارًا واحدًا: "خبز وماء وبن علي لا". ولئن بدت المطالب سياسيةً وبحثًا عن الحرية فإنها لم ترتفع إلى درجة التضحية بالخبز والماء، فالخطاب الثوري في بحثه عن الحرية رفع سقف التضحية إلى الحد الأقصى للبقاء على قيد الحياة، وهناك نكون أمام خطاب عقلاني دقيق ليس فيه من رومانسية الثورات شيء؛ نحن نثور حتى الحد الأدنى من توفر شروط الحياة. ولا ندري ماذا سيكون رد فعل التونسيين لو وقع تجويعهم وكان النظام أكثر شراسة وحجب عنهم الخبز والماء.
أما في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة سنة 2019، فقد ظهر الغذاء من جديد كورقة انتخابية وورقة للمناورة السياسية وبرز شعار "المقرونة" وأكياس العجين كورقة إغرائية من قبل مرشح الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، مما أدخل الهلع في نفوس منافسيه من النظام الحاكم ومن خارجه، لأنه سرق خطاب الأحزاب اليسارية والشعبية التي تستثمر في الفقراء، وخلصه من شعريته وبلادته القديمة ليقدمه فجًا وواضحًا للشعب الذي قضى سنوات مع حكومات متتالية يقلب عبارة "قفة المواطن" المهددة.
لم يعد الخطاب السياسي مع القروي يتحدث عن قفة أو كيس للمواد الغذائية التي قد تؤمن أسبوعًا كاملًا من الغذاء بل تأمين وجبة بوجبة، صار الخطاب يتحدث عن صحن المقرونة وليس الكيس، عن تقطير للحياة نقطة بقطة، وهناك حدثت الفوبيا الحقيقية والاستنفار عند الحشود لتنتخب هذا المخلص الذي سحق منافسيه، على الرغم من تواجده في السجن، وأجبر السلطة آنذاك على الإفراج عنه ليجد أمامه شخصًا آخر وثق فيه قسم آخر من التونسين لنفس السبب: الغذاء، وهو أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي راهن عليه الشباب وخريجو الجامعات والمعطلون، وهنا يتسع مفهوم الغذاء مع مشروع قيس سعيد ليشمل أمورًا أخرى غير معلنة بالحديث عن الإرادة. فكلمة إرادة مرتبطة بالقدرة، واستفزاز القدرة في الشاب اليائس فيه تلميح للقدرة الجنسية، والحق في الغذاء الجنسي لشباب بدأ يشعر باليأس من تكوين الأسر والزواج والإنجاب.. ذلك الشباب الناقم على السيستام الذي دفعه إلى حافة الخصاء. لتنتهي الانتخبات بقيس سعيد في القصر الجمهوري، ونبيل القروي في البرلمان، والحزب الثاني بعد حزب النهضة المنفرد بالغذاء الميتافيزقي باعتباره من أهم أحزاب الإسلام السياسي القادرة على إنتاج الحشود.
خطر التجويع والسياسة الهشة
لم تردع بعض الحكام العرب نهايات الطغاة الذين سبقوهم، والذين جعلوا من التجويع طريقهم الوحيدة للاستمرار في الحكم. فاستثمروا في الفقر والتفقير والاستبداد عوض التنمية والعدالة والديمقراطية. فلا شيء يطمئنهم على بقائهم كتزايد عدد الذين يقع السيطرة عليهم وكسب ولائهم بالعطايا. لذلك لا تسعى الدولة لتأمين التوازن الغذائي حتى في حالة توفر الإنتاج وتدفع إلى التخلص من ذلك الفائض الذي يهدد استقرارها. فما دام شعبها جائعًا فهي قادرة على التحكم فيه، وتابعنا ذلك في مصير فائض الإنتاج من الخضار والغلال والحبوب والحليب والزيتون في كل من تونس ولبنان وغيرها من الدول العربية، ورأينا الحبوب ملقاة في تونس حتى داهمتها الأمطار والسيول، ورأينا الفلاحين الصغار يدلقون الحليب ويرمون الزيتون والليمون والبرتقال والتمر في الطريق، ورأينا التفاح في لبنان على الطريق كذلك تدوسه السيارات.
عندما انتفض التونسيون سنة 2011 لإسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، رفعوا شعارًا واحدًا: "خبز وماء وبن علي لا"
كان الجميع يتساءل لماذا تتصرف الدولة بهذه الطريقة تجاه هذا الفائض من المنتوج المحلي هكذا؟ لماذا لا تتدخل وتقدمه للفقراء والمحتاجين؟
اقرأ/ي أيضًا: العزل في زمن كورونا وبحث الديمقراطية عن جمهور
إن تدوير فائض الانتاج للفقراء والمحتاجين سيجعلهم يغادرون طبقتهم ولو نسبيًا؛ طبقة الفقراء والتي تمثل الطبقة الأخطر في الانتخابات وفي العمل السياسي، فهي التي ستخرج لتنتخب، وهي التي ستشترى أصواتها، وهي التي تواصل الحلم بالتغيير، وهي التي تصدق ولو كذبًا كلام الساسة، لذلك يجب الاستثمار في جوعها والعمل على مزيد تجويعها وتحصينها من خطر الشبع الذي سيجعل الفرد منها يمضي في طريق أخرى من العيش ونمط التفكير وتتنهار كتلة الحشود. لذلك، وكما قال كل فرنسيس مورلاييه وجوزيف كولينز: "لن يكون هناك أمن غذائي حقيقي، مهما بلغ الإنتاج، ما دامت موارد إنتاج الغذاء يسيطر عليها أقلية ضئيلة، وتستخدم فقط لإثرائها".
هذا كله زيادة على الجريمة الكبرى المسكوت عنها في العالم العربي، وهي تغيير البذور، حيث استبدلت البذور المحلية التي يمكن أن تخزن ويعاد زراعتها ببذور قصيرة العمر يقع استيرادها كل عام، وبذلك صار أمن الشعوب نفسها مرهونة للخارج الأمريكي الذي انخرط فيها من عقود ضمن حرب الغذاء المستقبلية والتي بدو صارت واقعًا.
المقاربة الأمنية والتوحش على الباب
يخبرنا التاريخ العالمي والعربي الإسلامي أن التجويع قد يأتي بالكوارث، فغير إسقاط الأنظمة عبر الثورات والتمرد يمكن لسياسة التجويع أن ترتد بالإنسان إلى الوحشية والبدائية، وربما تتسبب في اختفاء الإنسان نفسه. يقول الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيجا أي جاسيت: "إن التاريخ يحكي لنا عن عدد لا ينتهي من التراجعات. لكن لا شيء يضمن لنا أن لن تحصل تراجعات أعمق غورًا من تلك التي حاقت بنا، ومنها أعمقها جميعًا: اختفاء الإنسان كإنسان وعودته الصامتة إلى درجات الحيوانية حيث يمحي امحاء نهائيًا لا رجعة منه".
فيذكر لنا البغدادي في كتابة الإفادة والاعتبار والمقريزي في كتابه إغاثة الأمة وغيرهما.. ما حصل في مصر عندما عم الجوع نتيجة انحسار مياه النيل. فقد توحش الإنسان والتفت إلى بني جنسه فأكله. ولم يردع هؤلاء لا دين ولا أخلاق وهم يصطادون الناس في الشوارع ليأكلوهم، بل وصل بهم الأمر أن أكلوا الجيف وأكلوا الميتة والمحكومين بالإعدام وتركوهم هياكل عظمية.
إن الحضارات المتقدمة ترتد إلى التوحش متى شعرت بالخوف، فها هي ظاهرة القرصنة البحرية الدولية تعود
إن حقّ أكل لحم العدو الذي تسمح به بعض جيوش الدول أثناء الحروب للبقاء على قيد الحياة ستستعمله الشعوب التي ستجوع إذا لم توفر لها دولها الغذاء، واكتفت بقمعها ليبقى المواطنون في بيوتهم حتى تحاصر هي الوباء وتحد من انتشاره، فالمؤن التي تتمتع بها طبقة اجتماعية يكفيها لتصبر بعض الوقت لا تمتلكها تلك الطبقات المسحوقة التي تخرج كل يوم تجمع القوارير والأكياس البلاستيكية، وتبيع الخضار على الأرصفة لتؤمن غذاءها اليومي.
اقرأ/ي أيضًا: الإنفلونزا الإسبانية.. حكاية "الوباء الشاحب" الذي عالجه العالم بالنسيان
إن الرجل العربي منذ عقود مضت، وعندما كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية ويمنعها من العمل ويعتبر نفسه مسؤولًا عليها ماديًا، سمح لنفسه أن يبني عليها بابًا بمعنى يحبسها في البيت بختم الباب، لكنه لم يكن يقدم على ذلك إلا بعد أن يوفر لها ما يكفيها مؤونة لسنة كاملة ما يحتاجه من وقت لكي يسافر للحج أو للتجارة ويعود. لذلك من واجب الدولة أن توفر للشعب ما يحتاجه قبل أن تغلق عليه الأبواب وتمنعه من الخروج، لأنه إن مس الجوع الوحشي تلك الحشود المحبوسة فلا شيء سيمنعها من التمرد ولن ترجعها عصي ولن يردها رصاص، ولعل هذا ما يحذر منه الفيلسوف أورتيجا أي جاسيت في كتابه "تمرد الجماهير".
فهذا الشيء الذي نسميه "المدنية"، كل وسائل الرفاه الطبيعية والأخلاقية هذه، كل وسائل الراحة هذه، كل هذه الملاجئ. كلها تشكل سلسلة أو نظامًا من الضمانات صنعه الإنسان لنفسه كالطوافة بعد تحطم السفينة الأولى الذي هو دائمًا قوام الحياة، كل هذه الضمانات ضمانات غير مضمونة سرعان ما تفلت من يد الإنسان في لمح البصر، ولدى أول بادرة إهمال ثم تختفي الأشباح".
إن الحضارات المتقدمة ترتد إلى التوحش متى شعرت بالخوف، فها هي ظاهرة القرصنة البحرية الدولية تعود، وتقع قرصنة بواخر تحمل الكحول والأدوية والمواد الطبية والأغذية. وها هو الاتحاد الأوروبي يشاهد ببرود إيطاليا وهي تشيع المئات من الضحايا يوميًّا (وصل 1000 وفاة يوميًا) ولا يتدخل لمساعدتها بل يغلق عليها الحدود. فإذا كانت الدول بدأت تتوحش لتأمين ما تحتاجه شعوبها لكي تبقى طيعة في يديها، فإنها لحظة تفشل في تأمين ذلك ستخرج تلك الشعوب نفسها لتقطع الطريق وتمارس قرصنة كل شيء، لنكون أمام ما يحذرنا منه توماس هوبز بـ"حرب الكل ضد الكل". فـ"عندما نتأمل الماضي، أي التاريخ، كما يقول هيغل، فإننا لا نرى سوى الأطلال".
إن الوحشي لم يغادر الإنسان كما لم يغادر ذلك الوحشي أسود ونمور السيرك، إنما هو كامن فيه وفيها ينتظر منذ القدم أن ينتقم من مروضيه ويستعيد طبيعته. لذلك على الدولة أن تلوح بالعصا وهي تضبط الخارجين عن القانون دون المسارعة باستعمالها كما يفعل مروض الأسود، الذي يضرب بالكرباج بيد أمامها على الأرض، ويقدم لها باليد الأخرى الغذاء وحبات السكر لكي تلعب وتنتج الفرجة.
إن هذه الاستعارة التي نذهب إليها مكرهين ما هي إلا حالة ظرفية لاستعادة الوضع الانساني كاملًا والخروج من حالة الراعي والقطيع الحديثة، وهو داخل في العقد الاجتماعي لنشأة الدولة عندما يتنازل الفرد عن حقه في استعمال العنف لصالح الدولة التي تحتكر العنف، والذي يصبح مشروعًا لكي تضمن له بقاءه حسب نظرية ماكس فيبر.
الوحشي لم يغادر الإنسان كما لم يغادر ذلك الوحشي أسود ونمور السيرك، إنما هو كامن فيه وفيها ينتظر منذ القدم أن ينتقم من مروضيه
لذلك على المجتمع المدني أن يعمل على ضبط توحش الدولة نفسها ضد شعبها هكذا نفهم بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "لا لاستغلال الحظر والحجر للاعتداء على المواطنين"، يوم 24 آذار/مارس 2020 الذي ذكرت فيه المؤسسة الأمنية بأن تتريث في استعمال القوة لرد الجماهير إلى البيوت في الحجر الصحي، بعد أن كان الجميع ينادي بإنزال الجيش لردع المتمردين على قانون الطوارئ وحظر التجوال. فتفويض الدولة لضبط الفضاء العام لا يعني ضوءًا أخضر للعودة لنظام القمع العشوائي، وذكرت أن حظر التجوال ليس ذريعة لتلبية غرائز القمع عند فئة معينة هي رجال الأمن، لأن استفزاز الغرائز قد يؤدي إلى انفجارها، ونصبح أمام فائض من الغرائز المتحررة ستفشل الدولة في التحكم فيه كما فشلت في التحكم في فائض الإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا: أزمة الخطاب الإعلامي المرئي في زمن الكورونا
وللسبب نفسه نفهم هبة الجماهير ضد القانون الردعي الذي تقدم به نواب الشعب لمعاقبة كل من يقذف نائبًا بالشتائم، وهو ما جعل مؤسسات وجمعيات من المجتمع المدني تقف مع الجماهير وتعترض عليها، ما جعل النواب يسحبون القانون. فهذا القانون يستغل الظرف لالتهام المكسب الوحيد الذي حققته الثورة وهو حرية التعبير بدعوى أخلقة المجتمع في وقت ترشح مداولات مجلس النواب بخطاب لا أخلاقي.
يبقى السؤال المحير كيف نواصل الثقة في الدولة وهي تسارع إلى رفع العصا؟ كيف نثق في دولة حديثة العهد بالديمقراطية ونحن نستعيد مشاهد الأمريكان في أول أيام الكورونا وهم يتزاحمون على محلات بيع الأسلاحة الشخصية؟ ليس أمامنا إلا أن نثق في الدولة ونراقبها، وأن نغلق آذاننا لكي لا نسمع الروائي الإيطالي ألبرتو مورافيا صاحب رواية "السأم" الذي يقول في ثقة بعدم وجود الثقة: "الإيطالي لا يؤمن بعدالة الدولة. فحين يجد نفسه مغبونًا ينتقم وحده". لكن هل قال مورافيا شيئًا غير ذلك الذي المنسوب إلى الحبيب بورقيبة: "فإنك إن جوعته انقلب عليك".
اقرأ/ي أيضًا: