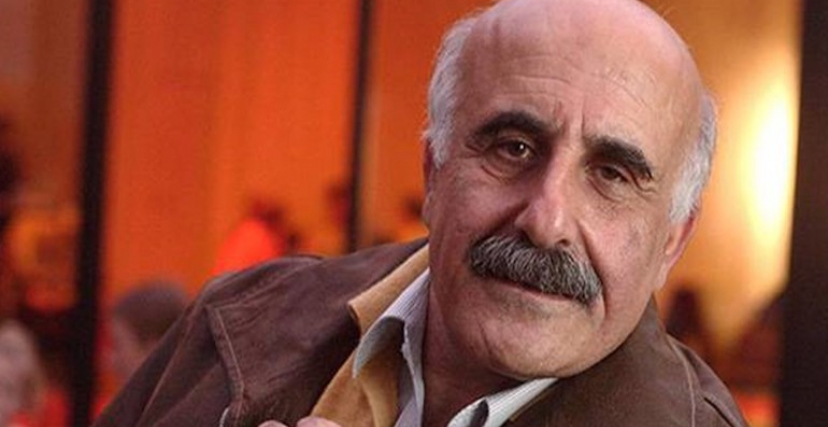في "لُفِظَ في البرد" (عام 2000) مجموعةُ عبّاس بيضون الشّعريّة مكابدةٌ صعبةٌ بينَ ما تسمَحُ بهِ الحياةُ من الشّعر، وما يخونُ أو يُخاتِلُ بهِ الشِّعر الحياةَ أو لا يخونُها بهِ بل يصفُها، كلُّ ذلكَ مِن خلالِ اللّغة الّتي هي أداة الشَّاعر الوحيدة، وبالتّالي هو هي. ولا ننسَ أنفسنا، كقارئ فالشّعر اقتراح والقراءةُ كذلك. خصوصًا أنّنا أمام شاعرٍ صعب، بل قاسٍ في تعاملِه مع الحال، واللّغة، والآخرين. وأحيانًا يضعُ أمامكَ القصيدةَ بأخلاطِها الأولى، فمَن سواهُ، على سبيلِ المثال يذكرُ أنّهم "لم ينبشوا" كما في قصيدة "كفّار باريس" أولى قصائد المجموعة "لم ينبشوا كفاية في المراحيض/ وكان يمكنُ أن يجِدوا فيها/ التّخطيطات الأولى للصّوامع/ والأضرحة/ إذا وجدوا حجارةً كانت تحيض/ فلأنّ الأسرار تخرجُ دائمًا مع الدّم/ والكائنُ يستفرغُ عظمَهُ ولبّهُ أوّلًا/ لا بدَّ أنّ مخاط البزّاقة الشّمسيّ/ جسورٌ الى مكانٍ مجهول/ فإنّ المراحيض وحدها متاحفنا/ لا فائدة من المطرقة/ ما من خطّة لتبديد الكائن".
الكتابة الشعريّة "بالمخرز" هي الّتي تَسِمُ مجموعة عباس بيضون، ولعلّها كتابة تمشي عكسَ سيرِ الكثير من سائدِ الوجدان الشّعريّ العربيّ في تاريخه وحاضره
الشّعر هنا، ليس لتلطيف الوجدان أو دغدغته، بل لبقرِ الوجدان بَقْرًا مُباشرًا بمخرزِ اللّغة، وكشفِ أحشاء "الحال"، والحالُ هو هذه اللّغة بالذّات، ذلك ما أشار إليه ت. إس. إليوت في ما سمّاه "المعادل الموضوعي" للشّعر أو القصيدة.
اقرأ/ي أيضًا: عباس بيضون في "الحياة تحت الصفر".. قصائد الحَجْر
هذه الكتابة الشعريّة "بالمخرز" هي الّتي تَسِمُ مجموعة عباس بيضون، ولعلّها كتابة تمشي عكسَ سيرِ الكثير من سائدِ الوجدان الشّعريّ العربيّ في تاريخه وحاضره، الوجدان العاطفيّ أو الغنائيّ، أو حتّى البلاغي.. وهي تحصّلُ صورتها أو وجدانها الخاصّ بها إذا كان لا بدّ من كلمة وجدان من هذا الاتّصال الفذّ والجارح بين "الموضوع" و"الذّات" والّذي تحقّقه اللّغة، فما دام ثمّة "دمٌ في سريرِ الحبّ" و"مخاط على خصلاتِ الشّعر"، فلماذا لا ينكشفان في القصيدة؟ على ما يقول: "لا تدنُ/ لهاثك يزيّت/ لا تدنُ/ مخاطك على خصلاتي/ والرّطوبة تجعلُ لعابَهم في روحي/ تعطيش الاشجار يجعلُها أقلّ ذبابًا/ لكنّ الذّباب أيضاً في المخيّلة/ إذ يحسنُ أيضاً تجفيف الحجرات/ وشراشف السّرير/ وأجزاء كبيرة من الذّاكرة واللّغة".
ويحسنُ أن نسأل، في "المعادل الموضوعي"، أين هو الذباب؟ على الشجر أم في الذّاكرة وفي اللّغة؟ وأين هو المخاطُ؟ على الخصلات أم في "اللّغة"؟ ويظهر أحيانًا أنّه ليس ثمّة من جدوى للسّؤال، أو للبحث والتّمييز. فما هو هناك هو أيضًا هنا... أو أنّ كلّ شيء ليس سوى قصيدة، في الشّعر.
يقول عباس بيضون: "كل شيء لفظ". ما جدوى السّؤال عن أصل الشّعر في الحياة. أو جذور ومحرّضات اللّغة، ما دامَ الشّعر هو الشّعر أو الوجود الشّعريّ. واللّغة مولودةٌ أصلًا من أجلِ أنْ تنفصلَ عن أصلِها، في قلبِ الأشياء. ومن الشّفتين، وهذه هي قوّة اللّغة وقوّة الشّعر، في ما يشبه الاستقلال، أي أنّه يعادل، في "اللّغة"، موضوعه في "الحياة". يقولُ بيضون: "لكنّك إذا نظرت إلى لون الجعة/ هدّأ روعك/ وقلت في سرّك: إنّ هذا مجرّد لغة" من قصيدة كفّار باريس.
والمسألة تصلُ بنا في هذا الشّعر إلى قوّة خاصّة به، هي قوّة "الوهم"، وهي قوّة كبيرةٌ مصدرُها المخيّلة، وأدواتُها في الكلمات. وعلى رغمِ معرفتِنا بمصادِرها وأدواتها، فإنّنا نعترفُ بهذه القوّة، ونمارسُها، ونفعلُها وننفعلُ بها. هنا ليسَ من الضروريّ أن يكونَ عباس بيضون قد عاشَ بالفعل في باريس لكي يكتب قصيدة "كفّار باريس" ولعلّه عاش هناك ردحًا من الزّمان، إذ هو يذكرُ الأنفاق والمترو والمشي فيه "كالمشي في الشرايين"، المهمّ أنّه قدر على اختراع المدينة من داخله الشّعري ومن جوفه الخاصّ... هكذا بكامل صفاتها الموجودة في القصيدة.
وما "لُفِظَ في البرد"، لفظَ ونطق. قد يكونُ حُكمًا قضائيًا. يقالُ "لفظ الحكمُ في" وتأريخه في البرد طقسٌ نفسيٌّ. وقد يكونُ ولادةً، أي خروجُ ما في الأحشاء إلى الخارج. وما بين "لُفِظَ" و"رُفِضَ" في اللّغة جناسٌ غير تام، لكنّهما تشتركان في إشارة المستور ودفعه إلى الخارج، طوعًا أو قسرًا. فلُفِظَ تعني رُفِضَ بشكل أو بآخر، وفي المعنى مسحة إدانة، او اتّهام. قصائد عباس بيضون تمشي في اتّجاه هو في جوهره إدانة هو في لبِّه نوعٌ من السّلب. نحن لا نجدُ أنفسنا معه، في صحبة شاعرٍ يسترخي بالقبول، ويدرجنا في هدوء القبول. شحنةٌ من التوتّر تصاحبُنا في القراءة. ثمّة كميّة من الإصابات، من المرض، والقرف، تصاحبُ القصائد. وقد يتركها الشّاعر تزيدُ أو يلحّ بها أحيانًا، ومن البداية، لكي يدرجنا فيها، بلا حرج "لماذا لسانك أسود؟/ قال الدوريّ: لأني نظرت في ماء وسخ/ لأنّ الغيوم جرداء وتتفلُ وربّما تبولُ في الأعلى"... "تتفلُ فوق صلعاتنا السّماء"... "البرد يجفّفُ كلَّ هذا البصاق"... "الغيم يتدكربُ في كلّ اتجاه/ جارًّا معهُ خيط مخاط ثخينًا/ دعوهُ يهدرُ من دون صوت/ باصقًا جملةً لا طرف لها... إلخ"، ثمّ إنّ السمّ موجودٌ في القصائد كطقس، كذلك المرض، والسّواد وبلا أدنى شكّ السّلب الذي يختصرُ كامل المجموعة-التجربة وكيانها... في كلِّ شيء، حتّى الحبّ. القصائدُ تنتهي بالجملة التّالية "ووجهك مريض بالقمر" من قصيدة ربيع المرض.
هذا الطقسُ الكافكاويّ الأسود في الشّعر يظهرُ كجناحِ غرابٍ ممدودٍ على جميع القصائد: "الهاتف أسود يا سيّدي/ ولا ينبح... لا تأمني أن يكون الغصن أجوف... قد تلسعكَ الزّهرة... املئي رأسك من بنج السّهرة... العصافير سوداء في قارورة الكحل... التفّاح أسود... إذا تعثّرت بنفسي قلت هذا سمّ بدني... مرضعتي السّوداء... إذا ظهر الهاتف الأسود/ ضريرًا، وربّما ميتًا".
قوّة "الوهم" قوّة كبيرةٌ مصدرُها المخيّلة، وأدواتُها الكلمات. وعلى رغمِ معرفتِنا بمصادِرها وأدواتها، فإنّنا نعترفُ بهذه القوّة، ونمارسُها، ونفعلُها وننفعلُ بها
وهذه الجملُ الشعريّة مقتطعةٌ من قصيدة واحدة هي الأخيرة في الدّيوان، بعنوان "ربيع المرض". ولعلّها قصيدةُ حبّ، لكن ربّما سمّيتها "القصيدة السّوداء"، قصيدةٌ مؤثرة ذات طقس مكفهرّ وأسود... بل أكثر من ذلك "سوداوي"... حسنًا، سيكون كلّ شيء يلفظ في القصائد تبيانًا من حيث هو "لفظ" أو إظهار، ولكنّه في الوقت عينه، إدانة من حيث هو رفض أو حكم. من البداية إلى النهاية، هكذا ستظهر في باريس أو في جوف الرؤيا الشّعرية الشمس مرسومة "باللون الجيري" ومتروكة "تسلح في مكانها"، "كاتدرائيات ضخمة" إنما هي "بلا وزن على الاطلاق"، رذاذ، يصل "ميتًا" ومع ذلك "تتنفسه"، الجسر، ولكن يسير عليه الأجنبي الشاعر، مثلًا كيتيم. وحده: "أنا يتيم هذا الجسر"، قساطل وضواحٍ من "فلّين"... الى آخر ما هنالك مما يمكن أن يولد أو يلفظ من أشياء وأسماء، ليضمحلّ فجأة، أو ليموت.
اقرأ/ي أيضًا: عباس بيضون: صُوْر
يكتب عباس بيضون في نهاية المقطع الثالث من "كفّار باريس" السطرين التاليين: ذلك كله لفظ في البرد ولم يطل مكثًا في البرد، وفي المقاطع التالية يتابع الشّاعر ما "لفظ"، و"لفظ"، ما ولد، ورفض فهو في داخل المدينة كما هو في داخله أو جوفه أسير النفق القوي النفق الغامض، المترو "غول باريس" و"غول الشاعر"، فما "من شيء في قوة النفق"، والمشي في الانفاق "كالمشي في الشرايين" والقطار الهائل الهائج "يرحل عكس النهار"، إنه، كما يقول "يرحل الى الوراء"، فما يصفه عباس بيضون هو مدينة يانعة بأسباب هلاكها... ليست باريس وكفى، بل هو أيضًا كمدينة... وكل ما يحيط به او يمرّ به من إشارات وأسماء، اشخاص واماكن وحوادث، ليس سوى تكئات لكتابته هو، لشعره، لذاته. خذ مثلًا، ذكره، في مقطع من مقاطع القصيدة لسمير خدّاج، الرسّام اللبناني المقيم في باريس، في غرفة تابعة لمستشفى الامراض السرطانية هو يقول: "سمير خدّاج المقيم في مستشفى للسرطان يصنع جداريّة كبيرة من أوراق الخريف/ السرطان أكل عروقها وبالتأكيد رائحتها/ لكنها مع ذلك أوراق للشفاء/ أهدي بعضاً منها إلى نهلا وحسن وأختي وأنا آكل منها أيضًا إذ لا أحتاج بعد إلى التأكّد من أنني لست مصابًا. رسم ياسمينة لم تظهر على اللوحة/ رسم شجرة بلا اي شجرة على الإطلاق".

هنا، سمير خدّاج، وسائر الاسماء والوقائع، مثلها مثل باريس ومعالمها وبعض إشاراتها وأمطارها والنفق والمترو والمقهى... كل شيء إشارات تمويه تقود إلى أصحابها لكنها دائمًا تخسر طرقاتها لتقود إلى الشاعر. أعني، على وجه التماثل والتقريب، مثل قوله إن اوراق السرطان أوراق للشفاء، وقوله في آخر المقطع "رسم شجرة بلا أي شجرة على الإطلاق".
وعباس بيضون في كتابته، لا يقدّم مراثي أو تفجّعات ولا يرغب أن يثير أي سخط أو قرف أو أي انفعال يرتبط بأعصاب عاطفية. هو هكذا يدفق كل شيء. كل الكلمات، دفعة واحدة، يلفظها، كولادة ضرورية ولا بد منها. ولا بد أن يخرج فيها الطفل مع الدم والرفث والقيح والصراخ. الفرح نابع من مجرّد الولادة، لا من أي شيء آخر... حتى إنّ ما يصرخ فيه من خلال كلماته، ليس ألمًا على وجه التحديد. هو كتم الألم. وصراخه، وإن كان يظهر احياناً كصرخة "مونش" في لوحته المعروفة للشخص فاغر الفم الجالس قرب خط مرور القطار، إلاّ انه ينطوي على كتمان، مكابرة تصل لحدود العدميّة، ويتكئ في قصيدته المسمّاة "بلا سبب" على احالات واستعارات من الماغوط والالياذة وربما نيتشه. يقول، في ما يذكّرنا بالماغوط في مسرحيته "العصفور الاحدب": "ماذا لو كان الملاك أحدب؟". وفي ما يحيل إلى نيتشه في قوله: "هذه الحياة... إنها اهون من أن نهتم بها... إننا نعطيها لخدمنا لكي يعيشوها" يقول بيضون: "ليس ألمًا/ إننا نتركه لخدمنا/ مع الحياة التي بالكاد احتجناها/ ونثرناها بلا حساب على رفقاء الطريق".
لا يقدّم عباس بيضون مراثي أو تفجّعات ولا يرغب أن يثير أي سخط أو قرف أو أي انفعال يرتبط بأعصاب عاطفية
في مثل هذا الدفق الاول، التلقائي ظاهرًا - في حين أنه مدبّر لمدّة طويلة ومخزون في اللاوعي، ولا نبرّئ الوعي الثقافي منه أيضًا - تخرج الكلمات والجمل والقصائد منثورة بتقنياتها ومفرداتها وتوازناتها. بين التدبّر الثقافي والانفلات الغريزي تتحرك قصائد "لفظ في البرد"، ما يشدّها خيط اسود قادر ان يشيعه بيضون في لغتها كما في احشائها. والدخول معه إلى دهاليز قصائده، شبيه بالفعل بالدخول إلى رسوم سمير خدّاج "المقيم في مستشفى للسرطان يصنع جدارية كبيرة من أوراق الخريف"، كما ورد في إحدى قصائد الشاعر، فالطقس النفسي واللغوي للقصائد طقس ضاغط، وربما لا يستطيع احتماله كثيرون من شعراء او قرّاء للشعر. ذلك هو استحقاقهم كما هو استحقاق الشاعر.
اقرأ/ي أيضًا: الوباء والأدب.. نبوءات ضائعة بين نجيب محفوظ وعباس بيضون
شخصيًّا، وبعد ان قرأت المقطع التالي لعباس بيضون: "لكنّ قلبي وفمي في مكان واحد/ قلبي وأسناني في مكان واحد/ في المحل ذاته/ في الثقب ذاته/ يعملان ويتعاضّان"، وجدت نفسي تجاه هذا الشعر، على رغم وقوفي في الكتابة، في مكان أسلوبي آخر، شبيهًا بالطبيب في قصة "العنبر 6" لتشيخوف، التي تأثِّر بها كثيرًا يوسف إدريس، وكتب على غرارها "لغة الآي... آي". والطبيب هذا كان يعالج مرضى في مستشفى للأمراض العقلية، وكان بينهم مريض فيلسوف يقول للطبيب أن الألم الحقيقي، والجنون، بلا إصابة، بلا تجربة، لا معنى له. وانتهى الطبيب، في آخر القصة، بأن أدرك صحة ما كان يدعيه المريض... هكذا أيضًا بطل يوسف إدريس في "لغة الآي... آي".
اقرأ/ي أيضًا: