في 2007 قدّم تشارلز تايلور عمله الجسيم عن العلمنة في الغرب، باسم "عصر علماني"، وقد اعتبره بعض نقاده- أحياناً بتسرّع- نوعاً من الفيبرية المُحدَثة التي ترى للجينيالوجيا الدّينية دوراً في تشكيل الغرب الذي لم يعد رغم ذلك دينياً؛ بل، ومثلها مثل أعمال مارسيل غوشيه، تقدّم الغرب، والمسيحية عموماً، استثناءً في عالم غير قادِر على الخروج عن الحرفية الدينية.
ورغم أنّ الغرب ما زال علمانياً، بل وإنّ غير الغرب يعيش كذلك في أفق تهمينُ عليه العلمنة، كما بيّن طلال أسَد في مقاربته الفوكوية (النقدية) للمسألة، إلاّ أنّه يبدو أنّ العلمانية- إن لم تكن العلمنة- ليست خاصيّة غير منازَعة، حتّى في الغرب. فصعود اليمين العالمي في العقود الأخيرة قد أعاد نقاشات ظنّ كثرٌ أنّها متجاوزة في علاقة الدّين والدولة. ففي الهند استطاعت حركة يمينية ثمانينية العمر أن تعيد حكماً شبه تيوقراطي عصفت به بتقاليد التمايز بين الدّين والدولة. وفي ميانمار أعادت حركة رهبانية شكيمة الدّين السياسي والتفت بذلك على الحريات الدّينية. وفي الكيان الإسرائيلي يبدو أنّ الصراع الثقافي بين الأشكيناز ويهود الشرق قد أدّى في النهاية إلى انقلاب ديني قام به اليمين. وغني عن القول إنّ هذا التراجع عن الأسس العلمانية في هذه الجهات الثلاثة قد تضرّرت منه الأقليّات المسلمة أولاً. ولكن القضية أكبر من هذه الحدود. ففي المواجهة الروسية-الأوكرانية أعيدت في البلدين مسألة الدّين والدولة وطرحت مسألة تعبئة الكنائس الأرثوذكسية خلف دولها، مؤديّة إلى سيطرة الدولة على الدين وقمع الاختلاف المذهبي. ويميل كثيرٌ من المراقبين إلى القول بنهاية الحرية الدّينية في البلدين بسبب هذه الحرب. وفي البرازيل أعاد جايير بولسونارو التحالف التاريخي بين الكنيسة والإقطاع والرأسمالية في مواجهة القوى الوطنية، مستعيداً بذلك القرن التاسع عشر اللاتيني أو سنوات اليمين العسكري في السبعينيات.
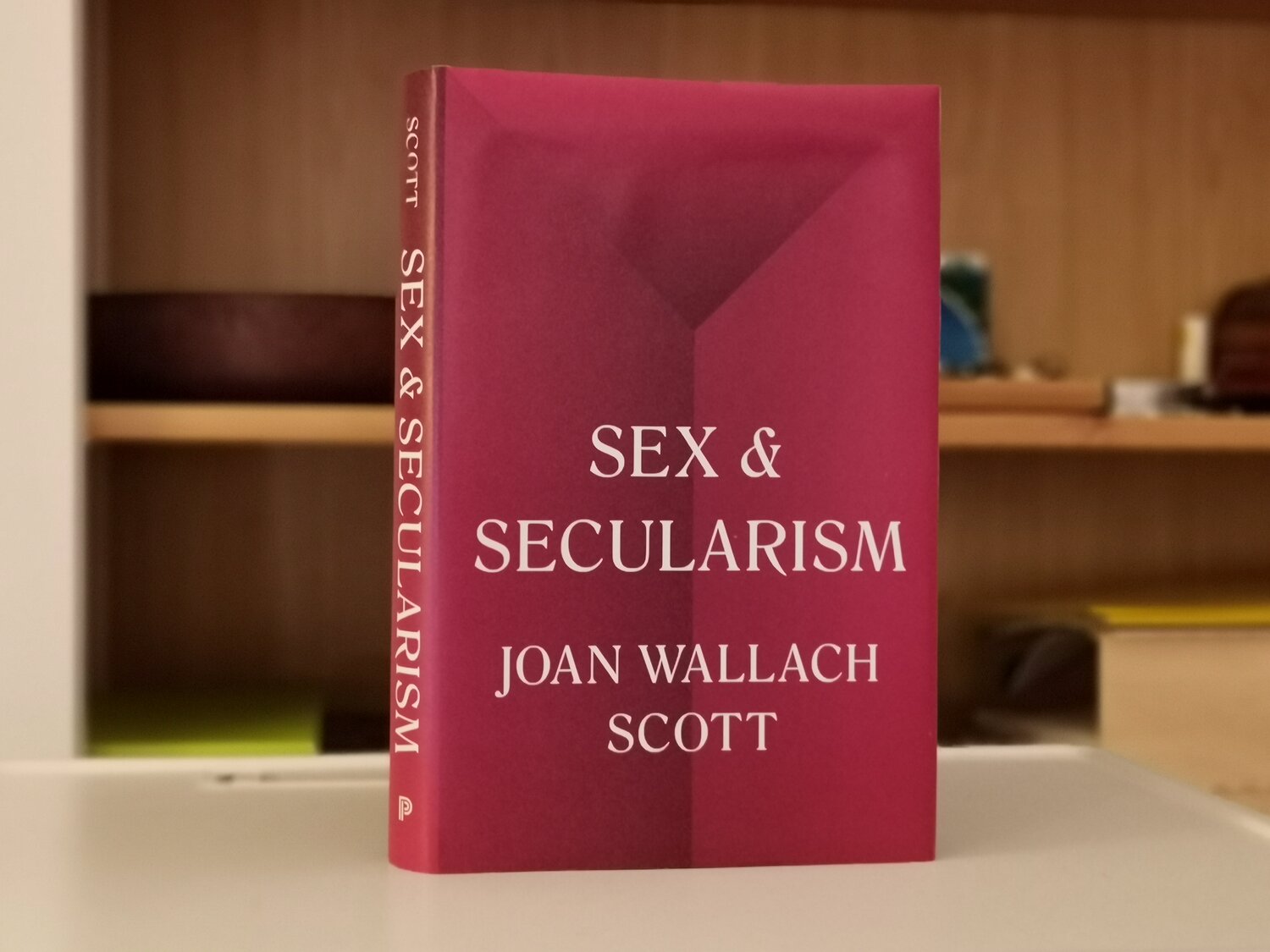
بل وإنّ الغرب يشهد كذلك إعادة طرح لمسألة الدّين والدولة. فرغم أنّ الولايات المتحدة- التي كانت استثناءً في الغرب بسبب نسبة الإيمان القوي فيها- قد شهدت في العقد الماضي أكبر عملية انحسار للتدين بانقشاع نسبة قد تصل إلى الثلاثين في المائة من المتديّنين، إلاّ أنّها بلد يشهد كذلك صعوداً قوياً لليمين المسيحي. وفي السنتين الماضيتين استطاع هذا اليمين القيام بحركتين سياسيتين كانت المسألة الدّينية في صميمها، وإن بطريقة غير مباشرة: الهجمة على البيت الأبيض في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، التي أرادت تمكين الانضواء اليميني والأصولي خلف ترامب؛ وإلغاء قرار "رو ضدّ وايد" في حزيران/يونيو 2022، الذي أعادت به الأصولية المسيحية طرح جسد المرأة في لبّ النقاشات حول الدّين والدولة. لقد دُرِسَ ما سمي في أميركا بالقوميين المسيحيين، وبالأخصّ كيف تقوم حركة مدنية-دينية نشطة بالتغلغل في المجالس المحلية والأهلية بما فيها المدرسية والبلدية لتمرير قوانينها الملهمة دينياً، وتخريب العلمانية الأميركية التاريخية القائمة على حائط جفرسون الشهير، الفاصِل بين الدِّين والدولة. أمّا في المجال العربي- الذي اعتبِر لوقت آخرَ مجال يُصارِع فيه الدّين القروسطي الدولة الحديثة- فصحيحٌ أنّ الربيع العربي قد أثبت هيمنة الأفق العلماني بقبول أطرافه الانتخابيّة الإطار التقليدي للدولة العربية، التي تجنّد الدّين للدولة ومؤسّساتها الاعتيادية، ولكنّه في ذات الآن ربيعٌ شهد استقطاباً أيديولوجياً قوياً بين الإسلام السياسي والعلمانية. ولكن هذا يصدق على منازعات العلمانية التي يقوم بها اليمين المسيحي والبوذي واليهودي في الأمثلة أعلاه: فيبدو أنّ صراعات الدّين والدولة الجديدة لا تقوم على تغيير البنية العلمانية للدولة (وهو أمرٌ يبدو متعذّراً لحدِّ كبير بفعل نمط الهيمنة الحديثة) بقدر ما تقوم على سياسات الهوية والتمثيل والسياسات الرمزية والاعتراف والصعود الطبقي والتحوّلات الثقافية، إلخ.
وعليه فيبدو أنّ نقاشات العلمنة، بما فيها تلك العربية منها، هي أيضاً نقاشات النماذج العلمانية. وحتى في المجال العربي الذي ما زالت نقاشات العلمانية فيه حبيسة الصراعات الحزبية منذ السبعينيات فإنّه أصبح يستدخِل محاججة التمييز بين العلمانيات، وأصبحت البرامِج الحوارية العربية، ناهيك عن المداخلات الشعبية والافتراضية، تذكُر باطراد أنّ هنالك نسختين من العلمانيّة: نسخة فرنسية معادية للدّين ونسخة أنجلوسكسونية مصاحبة له (بل وقد تمّ تداول نظرية متسرّعة ترى أنّ الديمقراطيات الغربية غير علمانية أصلاً). ولكن تعدد النماذج العلمانية هذا أصبَح يُطبّع وعياً متنامياً بتعدّد الخيارات في مسألة العلاقة بين الدّين عن الدولة. وفي هذا الإطار أصبحت الدراسات الأكاديمية الأخيرة تركّز على هذا السياق التاريخي للعلمنة وتحوّلاتها المتقادمة. يدخُل في هذا الإطار عمل المؤرّخة المختصّة بالتاريخ الفرنسي وبمسألة الجنوسة بوصفها خاصية تاريخية، جون والاخ سكوت، الذي صدَر عن برينستون وأكسفورد في 2017 بعنوان "الجنس والعلمانية" (Sex and Secularism). إنّه عمل يتوّج بعض أعمال سكوت المتعلّقة بالتواريخ الجندرية للعلمنة. ولكن ما يهمّنا منه حالياً هو تأريخها الفكري-السياسي للعلمنة المعاصِرة.

تقترِح سكوت أن يُنظَر إلى اختلاف العلمانيات من منظور الحرب الباردة. ففي البداية وجدت ثلاث علمانيات: العلمانية السوفياتية الملحِدة والمعادية للدّين (مع أنّه يجب الحذر من هذا التعميم، فالبلاشفة تعاونوا مع من سُمّوا بالرهبان الحمر وهم مجدّدون من الكنيسة الأرثوذكسية ضدّ الاتجاه الإقطاعي؛ وستالين، رغم قمعه لبعض القساوسة، كان نوعاً من هنري الثامن الذي أقام الكنيسة الأرثودوكسية الروسية على أسس وطنية). والثانية هي العلمانية الأميركية التي قامت على حماية الدّين من الدولة. أما الثالثة، وهي العلمانية الفرنسية، فكانت تقوم على حماية المجتمع والأفراد من المجتمع الدّيني. ترى سكوت أنّ التاريخ المعاصِر للعلمانية هو تاريخ إعادة تعريف هذه العلمانيات في سياق الحرب الباردة. فرغم أنّ العلمانية الأميركية قامت على تعاطُف مع الدّين فإنّ هذا غدا ملحوظاً جداً في سياق خطاب يمايز الترتيبة الأميركية عن السوفياتية. أمّا العلمانية الفرنسية فبغضّ النظر عما يُقال عن رفضها للدّين فإنّها صارت متعاطِفة معه في الحرب الباردة. يتعلّق هذا بحسب سكوت بمسألتين: الأولى أنّ قيادة الغرب انتقلت إلى الجانب الآخر من الأطلسي وأتى هذا معه بوشائج من التعاطف الأميركي مع الدّين وإشفاع العلمانية الأوروبية به، ما أدى إلى إفراز المسيحية الديمقراطية كخيار سياسي في أوروبا. أمّا الثاني فيتعلّق بوضع الرأسمالية في لبّ المسألة الدّينية. ولقد ساهم هذا في تحويل العلمانية الغربية من علمانية القرن التاسع عشر، المعادية لرجال الدّين، إلى علمانية حنونة بالدّين ومتصالِحة معه.
يتعلّق التأهيل الأميركي للدّين في سياق الحرب الباردة بجعل الدّين نبراساً للأمة. وكان هذا واضِحاً لأيزنهاور الذي بدأ يواظِب على الكنيسة ويكرّر أنّ الدّين تعبير عن الأمريكانية المناقضة للشيوعية. وكانت سنوات الخمسينيات معلمية في هذا حيث اتخذت تدابير رمزية لإعادة تأهيل الدّين في السياسة منها اعتماد أمة واحدة "تحت ظلّ الله" في قسم الولاء للعلَم في 1953 واستحداث عبارة "نثِق في الله" على الدولار في 1954 وجعلها من شعارات الأمة بعد ذلك بسنتين. وتلاحظ سكوت مقابل هذا في السياسات الغربية في بريطانيا وكندا وفي غرب أوروبا، مشتبكة في ذلك مع المؤرّخ صامويل موين، الذي حاجَج أنّ سياسة الغرب في الحرب الباردة كانت إقلاباً للعلمانية التقليدية. ولكن سكوت تُبيّن أنّه ماهى في ذلك بين العلمانية والإلحاد. ولكنّهما يتفقان أنّ أوروبا شهدت تأهيلاً للدِّين السياسي من خلال صعود الأحزاب المسيحية الدِّيمقراطية في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا. وصحيحٌ أنّ هذه الأحزاب قد اضمحلّت اليوم وأنّها صارت أحزاباً علمانية من حيث أنّها تروم إقامة عالم رأسمالي بقيم فردانية معلمنة؛ ولكنّها في مرحلة ما ابتغَت تشكيل أخلاقٍ مسيحية في المجال العام.
تبيّن سكوت أنّ جزءاً من تمايز العلمانية السوفياتية عن الغربية حدَث في الصراعات على تعريف النظام العالمي، وبالأخصّ حول نقاشات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1848. فحيث رفض الغربيون للسوفيات إقحام التشديد على حرية الإلحاد في الحريات الاساسية مقابلاً لحريّة الأديان، فإنّ حواراً داخلياً جرى بين العلمانية الأميركية والفرنسية. أراد الأميركيون إقحام عبارة أنّ الله هو مصدر الحقوق، ولكن الفرنسيين اعترضوا بامتناع مصدرية للقانون من غير إرادة الناس. وطبعاً يمكن إرجاع هذه الاختلافات إلى تاريخ فكري يتعلّق بتحوّلات نظرية الحقّ الطبيعي وتعدّد المواقف التنويرية من الدّين. ولكن ما يبدو منها هو أنّ الخلاف بين البنية العلمانية الغربية- وليس فقط بينها وبين السوفياتية- كان أساسياً في الصورة المعاصِرة للعلمانية. يكمن هذا التمايز بين علمانية أوروبا وأميركا في انتهاج الأوروبيين في سياق الحرب الباردة خياراً يتيح حماية الدّين ولكنّه كذلك يتيح كذلك رقابة الدولة عليه. فهنالك علمانية تلِحق الدّين بالدولة (يمكن نسبة النسخة الفرنسية والمصرية والتركية لهذا) وهنالك علمانية تفصلُهما (وهو نظرياً النموذج الأميركي). وترى سكوت أنّه لا يمكن فهم العلاقة المتوتّرة بين الإسلام والدولة في غرب أوروبا خارج هذه الجينيالوجيا من الحرب الباردة.
تقترح سكوت أن الرأسمالية كانت جزءاً أساسياً في تمايز هذه العلمانيات. ففي ابتغاء التباين مع السوفيات قام الخطاب الغربي على تقديم الدّين أنّه خيار. وقد استقدِم في هذا خطاب الرأسمالية القاضي بأن جوهر الإنسان تحقيق خياراته وإعادة اعتبار الدّين ليس فقط اختياراً فردياً، بل واستهلاكياً. وبما أنّ الدّين المُختار هنا هو المسيحية فقد رُتّبت العلاقة بينها وبين الدّيمقراطية فأصبَح الاعتناق الدّيني نفسه مثلاً على الدّيمقراطية. وهكذا سُمِح للدّين أن يعود للمجال العام بذريعة الديمقراطية والاختيار. وتلاحِظ سكوت أنّ اللغة السياسية الغربية في الحرب الباردة اتجهت إلى كسو الاختيارات الدّينية بلغة رأسمالية فأصبحت التعاقدات الاختيارية "مقدّسة" وأصبحت العلاقة بين العابد والمعبود علاقة "تعاقدية"، وقُدّم التقليد المسيحي أنّه الأضمن لهذه التعاقدات. وتتجلّى هذه اللغة في خطابات الزعماء الغربيين منذ الستار الحديدي لتشرشل في 1946، ومراهنة ترومان على حلف الأديان ضدّ السوفيات، وخطاب وأرنست بيفين، وزير خاريجة بريطانيا، كما مداخلات أيزنهاور وجون ماكدونالد، الذين أعادوا تأهيل المسيحية سياسياً باعتبارها نقيضاً للشيوعية، وباعتبارها، بصفتها المعلمنة هذه، تعبيراً عن الروح الثقافية للغرب. وترى سكوت أنّه بدون هذا لا يمكن فهم صعود البروتستانتية السياسيّة في أميركا. كما أنّها تُفسّر تنامي المحاججات الفيبرية بخصوص الأصول اليهودية المسيحية للنظام الغربي.
وماذا عن الإسلام؟ تحاجج سكوت أنّ قضية الإسلام في الغرب تقع في لبّ هذه الإشكاليات. فالأوروبيون في صياغاتهم للمعاهدة الأوروبيّة أقاموا الحرية الدّينية نقيضاً للاشتراكية السوفياتية واعتبروها هويةً أوروبيّة، ولكنهم ارتأوا أن يُعطوا للدولة الحقّ في تعليق الحريات الدّينية إذا تعارضت مع أمن الدولة. ورغم أنّ هذه ترتيباتٌ من الحرب الباردة إلاّ أنّها غدت نبراساً في تحجيم الحريات الدّينية للمسمين فيما بعد هذه الحرب. ولكن العلاقة الغربية بالإسلام أعقد من ذلك. فمن ناحية عبأ الخطاب الغربي التواريخ الاستشراقية في مقارنة الخطر السوفياتي بالغزوات الإسلامية على الغرب في غابِر العصور؛ وطابَق الخطاب بين الإسلام والسوفيات من حيث العقلية الجمعوية واللاعقلانية، و"الإنتاج الآسيوي" و"الاستبداد الشرقي" إلخ، وهي الأشياء التي دعت برنارد لويس إلى القول بأنّ الإسلام سيكون حليفاً للسوفيات بسبب شبههما الحضاري. وكان ذائعاً في فترة الحرب تصوير السوفيات بخصائص عثمانية أو إسلامية، كما تًشير إلى ذلك آداب الملصقات والرسوم والجداريات السياسية في العواصم الأوروبية آنذاك. ولكن من ناحية أخرى رُتّبت صداقة بين الإسلام والمسيحية والعلمانية الغربية، فعُبّئ الإسلام في تحالف سماوي، إبراهيمي، ضدّ الإلحاد السوفياتي. (إنّ قضية تعبئة الإسلام لصالح الغرب في الحرب الباردة قصة معلومة، لعلّ آخر الأعمال المنشورة بالعربية التي تطرّقت لها كان عمل جوزيف مسعد، الإسلام في الليبرالية، الصادِر في 2018 بترجمة المؤلف والمتكلّم). وتورِد سكوت سردية شبيهة وبالأخصّ ما تعلّق منها بتعبئة الإسلام الأصولي ضدّ الاشتراكية وضدّ القومية العلمانية لجمال عبد الناصر، وهو التحالف المقدّس الذي سيبلغ أوجه في تعبئة المجاهدين ضدّ السوفيات في الثمانينيات من خلال عملية منسّقة بين الاستخبارات الغربية والإسلامية، وبالأخصّ الباكستانية والسعودية وفي تدمير الإمكانيات التقدّمية للحضارة الإسلامية المعاصِرة واستبدالها بالمنعرج الأصولي الذي لم تخرج منه منذئذ.
إلاّ أنّ سكوت تُبيّن أنّ هذه العلاقة المعقّدة للغرب بالإسلام في سياق الحرب الباردة تُفسّر مصير الإسلام في الاستراتيجية الدولية فيما بعد ذلك. فبدلاً أن ننظر إلى خطاب "صراع الحضارات"- الذي اقترَح به صمويل هنتغتون عدواً جديداً للغرب بعد اندحار السوفيات- أنّه إنهاء للتحالف بين الإسلام والعلمانية الغربية والنظر لـ"الحرب على الإرهاب" على أنّها تجليات هذا، فإنّ الأسلم من وجهة نظر سكوت رؤية هذا في سياق التاريخ المستمِرّ للحرب الباردة. فالحرب على الإرهاب داخلة في منطقها المتمثّل في فصل الدّين عن الدولة مع حماية الدّين والدفاع عنه. كلّما في الأمر أنّ الخطر على الدّين لم يعد الإلحاد، بل صار التأويل المتطرّف للدّين؛ وبالأخص صار ينظر للإسلام أنّه يعاني من مشكلة في هذه الجبهة. وتتعرّف سكوت على تاريخ مثابِر آخر لهذه الحرب البادرة من خلال تقديم مصالحة أخرى بين المسيحية والديمقراطية في مجابهة الإسلام الذي يُقدّم أنّه لم يفلِح في المصالحة. وتورد سكوت في هذا عدّة مقولات للزعماء الغربيين المعاصِرين من جورج بوش إلى ساركوزي وميركل أكّدوا فيها العلاقة بين المسيحية والديمقراطية، وهي المتلفظات التي توجد في خطاب هنتغتون كما البابا بنديكت السادس عشر، كما في حوارِه مع هابرماس. فالبابا لم يتورّع عن تقديم الإسلام نقيضاً للمسيحية التي صارت متصالحة مع العلمانية؛ وهابرماس، مثله مثل مارسيل غوشيه وتشارلز تايلور، أقرّ بالاصول المسيحية للعلمانية الغربيّة. ومنها صار الحديث عن الاستثناء الإسلامي ممارسة استشراقيّة تريد منع الإسلام من قابلية التحقق العقلاني.
يراجع عمل جون سكوت بعض المسلّمات عن العلمانية ويمكن، لو تُرجِم، أن يُساهِم في إعادة إطلاق البحوث والنقاشات حول هذه المسألة في المجال الناطِق بالعربية
إن عمل جون سكوت ليراجِع بعض المسلّمات عن العلمانية ويمكن، لو تُرجِم، أن يُساهِم في إعادة إطلاق البحوث والنقاشات حول هذه المسألة في المجال الناطِق بالعربية. يمكن انتقاد العمل على عدّة أشياء منها مقاربته السياسية حصراً لتاريخ الأفكار، ممّا قد يؤدّي إلى رميه بالاختزالية. كما أنّه على أهمية اقتراحها إرجاع التوتّرات بين الدّين والدولة في مجال العلاقة بين الغرب والإسلام إلى الحرب الباردة، فإنه يلملِم التواريخ ما قبل الباردة، بما فيها الاستعمارية وحتّى القروسطية، لهذه العلاقات والتحوّلات في بنية العلمانية. ومهما يكن من أمرٍ فإنّه عمل يحرّك بعض المياه الراكدة في مسألة تأريخ العلمنة وصنوها وبمعنى ما منتجَها، ألا وهو الدّين المعاصِر.
