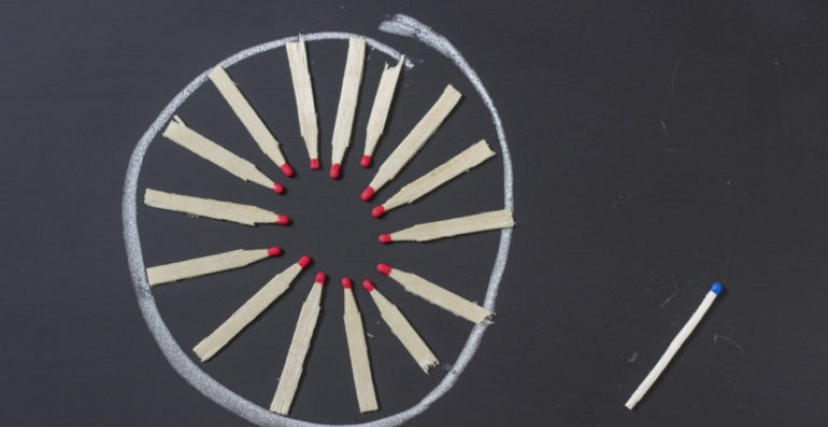يكاد يكون من البديهي القول بأن اجتماع البشر يتأثر، سلبًا أو/و إيجابًا، بطبيعة النظم الحاكمة وأبنيتها ومؤسساتها وشكل السلط وطريقة توزيعها، ومجمل الأوضاع الاقتصادية والثقافية التي تتفاعل معها. والواقع السائد ينطق بهذه الحقيقة يوميًا، إذ بلغ التأثر حدًا كبيرًا وبأشدّ الدرجات وأعمقها، ماديًا ونفسيًا وروحيًا، بل إن جلّ المكوّنات التي تأتلف منها حياتنا اليوميّة قد شوّهها الاستبداد وغياب الحريّة والحرمان من الحقوق الأساسية ومقوّمات العيش الكريم. وينسحب هذا التأثير على الدين أيضًا، إذ يطرأ عليه ما يطرأ على أي فكرة تقادم عهدها، وهو يحتاج دومًا إلى من يجدّد النظر فيه ويهذبه من زوائد ألحقتها به أنظمة الاستبداد والقهر وأجهزتها الأمنية والإعلاميّة، وبناها الاقتصادية، وما تجنح إليه من قمع أصوات النقد المباشر والإصلاح الشامل.
الدين يطرأ عليه ما يطرأ على أي فكرة تقادم عهدها، فهو يحتاج دومًا إلى من يجدّد النظر فيه ويهذبه من زوائد عديدة ألحقتها به أنظمة الاستبداد وأجهزتها
في واقعة، غير نادرة، حصلت مؤخرًا في الأردن، نالت إحدى الشخصيات العامة نصيبًا مقلقًا من التثريب والتكفير واللعن، لمجرّد التعبير عن رأي، انطباعي وفرديّ خاص، بشأن شعيرة إسلامية راسخة مجتمعيًا. تجترح الكاتبة في رأيها الذي نشرته عبر منشور على حسابها الشخصي، خطيئة التفكير بصوت عالٍ وطرح تأويلات جديدة لشعيرة "الأضحية"، بما تراه يتوافق مع منظومتها الفكرية وحساسياتها الشخصيّة، ومنطلقة ربّما من شعورها، المحقّ، بأنّ لها الحريّة المبدئية في التعبير عن رأيها، أيًا كان مقدار الافتراق فيه عن الرأي السائد شعبيًا، ورسميًا.
التفاعل العمومي مع ذلك الرأي، الغريب بطبيعة الحال، كان طبيعيًا، ذلك أن السلبيّ في الغرابة هنا لا يتعلّق بخطل الرأي نفسه، بقدر ما يدلّ على مساحة الاختلاف الضيّقة في المجتمع، ضمن حالة الاحتقان العصابيّ فيه، والشعور المستمرّ بالتهديد والاستهداف ضمن الشروط الاستبدادية القائمة. لكنّه مع ذلك رأي أراه على المستوى الشخصي مستهجنًا، بل وربّما يجادل البعض بأنه يعوز التعبيرَ عنه بعض الحكمة واللباقة الاجتماعية. لكنّ الأغرب أكثر، هو خروج الردّ الشعبي عن الإطار الطبيعي المتوقّع له، حين التقط هذا الانزعاج دعاة وإعلاميون و"سياسيّون" (بمعنى الطامحين بمكافآت السلطة وتنفيعاتها)، فراحوا يخلطون حقًا بباطل: الحقّ المتعلق بغرابة الرأي الجديد واستهجانه والحق في الاختلاف معه وتفنيده، وباطل تكميم الأفواه والإدانة المطلقة والاستتابة الشرعية "القانونية"، والدعوات لشطب كينونة كاملة، ليس من دائرة الدين وحسب، بل ومن دائرة المواطنة أيضًا، والتي يفترض أنها تستلزم حقوقًا أساسيّة، في مقدمتها المساواة الأخلاقية مع بقيّة المواطنين، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو فكري.
هنا نجد المجتمع ضحيّة للنخب والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستغلّ عواطفه الأساسية وتجيّرها لصالحها، في معارك وهميّة تختلق الخصومة والعداوة، لأغراض انتهازيّة وغير سياسيّة في جوهرها، أي أن من شاركوا في مراسم الإعدام المعنوي لتلك السيّدة، ليسوا في معركة سياسيّة يستغلّ فيها طرف أخطاء خصمه السياسيّ، في سياق حياة سياسيّة للرأي العام فيها تأثير على صناديق الاقتراع. هكذا نرى كيف يقدم هؤلاء على إشعال فتيل هذه المعارك الرخيصة، ولو على حساب أمّة المواطنين ووعيهم، وهي الأمّة التي تحتاج أكثر ما تحتاج اليوم، إلى الخروج من دائرة الاستبداد والقمع والرأي الواحد، إلى دوائر الحريّة والتعدّدية السياسية والفكرية، ضمن ثقافة مشتركة تحتمل في أصلها هذا الاختلاف، بل وتحتمل ما هو أكبر منه. فالمجتمعات العربية اليوم بحاجة مصيرية إلى أن يترسّخ فيها التعدّد التعايشي في جميع الممارسات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية العامة، وبما ينعكس إيجابيًا على سيرورة الانتقال إلى مجتمعات ديمقراطية حرّة قادرة على التعبير عن نفسها، بعيدًا عن هيمنة سلطة الاستبداد المتوارثة، بكل أشكالها، والتي أثبتت مرارًا قدرتها على الاستفادة من التطرّف بمختلف أشكاله، من أجل تعطيل أي تحوّل ديمقراطي. بل إن العقد المرير الماضي قد أثبت مجددًا استعداد أنظمة الاستبداد العربية لإنتاج هويات تحت وطنيّة حينًا وفوق وطنية حينًا آخر، واستغلالها وتجييشها، ولو كان ذلك على حساب السلم الأهلي وحقوق المواطنة، وذلك لكي تبقى هي المسيطرة على اللعبة، والقادرة على ابتكار قواعد جديدة لها، لتضمن إعادة إنتاج ذاتها، في آباد استبدادية، كالأبد الذي يستشرفه بشّار الأسد ومن هم على شاكلته.
في مقاله الأخير في القدس العربي، يرى ياسين الحاج صالح، أنّ الاعتدال، في الإسلام المعاصر، فردي، "بينما التشدّد جمعي ومنظّم"، بخلاف ما يكون عليه الحال في المجتمعات المستقرّة الكبيرة وصورة ثقافتها الجمعية السائدة. ولعلّه قصد هنا بطبيعة الحال، الممارسات الاجتماعية العينيّة للتديّن، بمعنى أنه يحيل إلى مسألة اجتماعية تتعلّق بالتدين وأنماطه، لا الدين نفسه وأصوله. وما يزيد هذا التشدّد الجمعي تعقيدًا بحسب الحاج الصالح، هو الغياب المزمن للتدخّل الاحتجاجي من "عقلاء المسلمين"، بل وإعراضهم "استكانة وخنوعًا"، عن مواجهة أصوات التعصّب والتعبئة الشعبويّة الديماغوجية. وهذا ما كان غائبًا بشكل لافت في الواقعة التي أشرت إليها أعلاه، حيث غابت إلى حدّ كبير، أصوات الحكماء، الذين يناقشون الآراء برويّة، ويتفقون معها أو يردّونها، بلا تطاول ولا تهديد، مع إعلان الرفض القاطع لتدخّل سلطات غير ديمقراطية لقمع هذا الاختلاف، بحجّة "الحفاظ على دين الناس"، وهي باستبدادها ورجعيّتها أكبر تهديد لدين الناس ودنياهم معًا.
ثمّة تشنّج جليّ في التعاطي المجتمعي مع الاختلاف، يغذّيها كما أوضح الحاج صالح في مقاله، حالة من غياب أزمة الضمير، وانعدام الشجاعة لدى النخب، تلك الشجاعة المكلفة، لما فيها من انشقاق وقلقلة للبديهيات وانفصال عن موروث الاستبداد والديكتاتورية وآثارها في الثقافة السائدة. تلك الشجاعة التي تعلن بأن الثقافة "ملك للجميع"، وأن هذه الثقافة ليست هي الثقافة الأحاديّة التي يُراد فرضها ولو قهرًا، ولا هي كذلك تلك الثقافة المعولمة الاستهلاكية الباهتة، بل هي الثقافة الإيجابية التي تحمي الحريّة وتستوعب الاختلاف وتحتضن الاجتهاد الفكري الحرّ وتحرّض على الإغناء المعرفي والشجاعة النقديّة، وتحرص على دقرطة الثقافة والتعبئة الديمقراطية والحقوقية، بما يضمن تحقيق المنفعة العامّة ضمن سيرورة التحوّلات التي تشهدها بلادنا العربيّة كافّة.
يحتاج المجتمع العربي إلى ثقافة إيجابية تحمي الحريّة وتستوعب الاختلاف وتحتضن الاجتهاد الفكري والإغناء المعرفي
هذه المطالبة الأساسيّة بالحريّة وما تقتضيه من القدرة على الانفتاح على المختلف والغريب واستيعابه، لا تتعارض مع المرجعيّات التي تتكئ عليها الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، سواء ما تعلق منها بالإيمان المشترك واللغة المشتركة والمكان المشترك والتراث المشترك، أو ما أسماها الكواكبي "الجامعات الكبرى"، من دين وجنسية ولغة وعادات وآداب، كما أن ذلك لا يعني في المقابل الركون الانتهازي إلى أي ثقافة مقولبة تشكّلت في عوالم الاستبداد وبأدواته، لاسيما في عصر الأمننة والرقابة الشاملة، وعلى نحو يحرم نشوء ونموّ علاقات عضويّة أصيلة بين المجتمع والتراث الذي يفترض أن يشكّل اللحمة التي تبرهن على أصالة الانتماء المشترك رغم اختلاف الآراء وزوايا النظر، فلا يكون هذا الإنسان مقطوع الصلة بهذا التراث من جهة، ولا يقمع التاريخ ويلغي الحاضر ويخطفه، لاسترضاء العامّة والتكسّب المؤقّت على حسابهم بالتحالف مع الاستبداد وباللجوء إلى أدواته التي لم تقم أصلًا إلا لمنع العدل وسلب الحريّة.
اقرأ/ي أيضًا:
الطرق الصوفية بالمغرب.. دين وطقوس وسياسة
بشار الأسد واعظًا.. جناية السلطة ضد النص والتفسير!
التراث الصوفي وتجديد الخطاب الديني