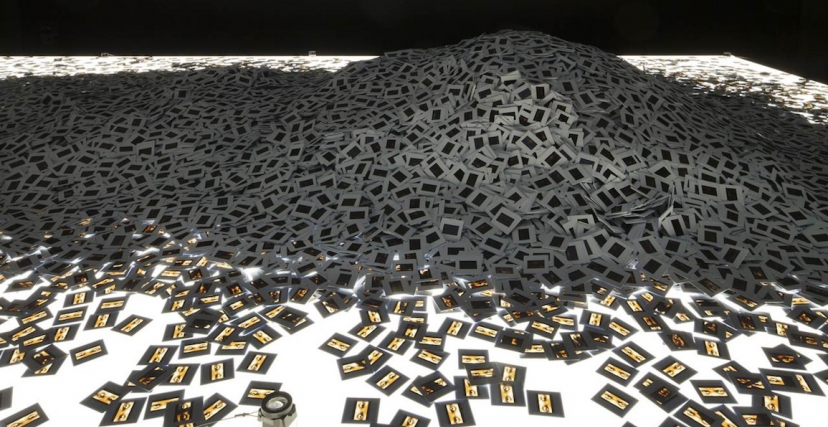سرد برعاية الشاعر
كنت أقيم في مقرّ "اتحاد الكتّاب الجزائريين"، عام 2002، مع الشّاعر طيّب لسلوس، قبل أن يلتحق بنا الكاتبان الخيّر شوّار وعلي مغازي. نبيع الكتب نهارًا، ونخوض في الأفكار والأحلام والأوهام والنّميمات ليلًا. أحيانًا نطبخ بأنفسنا، ونقصد المطعم أحيانًا. هذا إذا جاز لي أن أسمّي ما كنّا نطبخه طعامًا.
كنت أخاطب الرئيس من الأسفل: "سوف لن تدخل التاريخ ما لم تحرر البلاد من الجوع الثقافي"
جاءت فاتورة الكهرباء، فتماطلت إدارة الاتحاد في دفعها، ممّا أدّى إلى قطع الضّوء عنّا. وهو الوضع الذي مهّد لانضمام كائناتٍ جديدةٍ إلينا، هي الجرذان السّمينة. خفناها في البداية وحاربناها، ثمّ تعوّدنا عليها وصالحناها، حتى أنّنا كنّا نطلق على بعضها أسماءً. سلام على "حفيظة"، وهي تدخل علينا، من غير خوفٍ منها أو تحفّظٍ منّا، فتأخذ مرغوبها من الأكل، وتغادر في طمأنينةِ كاتبةٍ جاملها النّقاد.
اقرأ/ي أيضًا: الرواية بحسب ميلان كونديرا
ذهب طيب لسلوس، ذات "ويك اند"، ليتفقّد صغارَه في "الدّوسن"، وذهب شوّار ليتفقّد والديه في "بير حدّادة"، فواجهتُ كثرة الظلامِ وقلّة الكلام. ولم أنتبه إلى أنّ "حفيظة" سبقتني إلى صحن العدس، فثقبتني أوجاع تعجز اللّغة عن وصفها، تمامًا كما عجزتُ عن الوصول إلى الباب الجانبيِّ لمقرّ الاتحاد، حتى أخرج إلى خلق الله، فيأخذوني إلى المستشفى.
كنت أزحف على بطني في الظّلام، فتنير في مخّي صورتا أبي وأمّي، اللذين تركتهما في قرية "أولاد جحيش"، ودخلت العاصمة بحثًا عن وجودٍ سينتهي بعد لحظات. من هذا الذي أكل من الصّحن نفسِه مع الجرذان وأفلت للموت؟ من هذا الذي سيدخل علي لأحمّله رسالةً أخيرةً لهما؟ تذكّرت رواية "الحلزون العنيد" لصاحبها رشيد بوجدرة، وقد حرّرتني، سابقًا، من عقدة فأرٍ عضّني في الصّغر، فضاعفتُ زحفي وإيماني بالوصول. بلغتُ السلّمَ الرّخاميَّ، فلم أمهل نفسي كي تفكّر في طريقةٍ مثلى لنزوله، فأسلمتُ نفسي للكركبة عليه، حتى لا أخسر وقتًا يجعلني أخسر حياتي.
يعرف الذين يعرفون مقرّ اتحاد الكتّاب، أنّ المسافة بين أسفل سلّمه الرّخاميّ وبابه الجانبي، لا تتجاوز عشرة أمتار، لكنّني قطعتها زحفًا على بطني في ساعةٍ أو أكثر بقليل. بلغتُ الباب الحديديَّ، ففقدت الإحساس بنفسي، ولم تبقَ إلا أصوات السّاهرين من الشّبابِ، خلف البابِ، تصلني متقطّعةً، فأكملها في خيالي. هل كنت أضحك، وأنا أسمعهم، أم كنت أبكي؟ هل عرفت طيّب لسلوس والخيّر شوّار، وهما يدخلان عليّ صباحًا، أم حسبتهما ملاكين نزلا ليُنقذاني من السّماء؟
لقد اتخذتُ قرارين، بعد أن شفيتُ تمامًا، هما التخلّص من "حفيظة"، والجلوس خلف الباب الجانبيّ لمقرّ اتحاد الكتّاب، كلَّ ليلةٍ. لأبحر في حكايات شباب شارع ديدوش مراد. من غير أن أنتبه إلى أنّ ساردًا صغيرًا بدأ يتشكّل داخلي، تحت الرّعاية السّامية للشّاعر، الذي كان قد قطع أشواطًا في الإنصات لذاته.
الواقع والخيال
كنت أقيم، عام 2004، في قبوٍ أسفل الجامع الكبير، الذي يصلّي فيه الرّئيسُ الأعيادَ، رفقة ثلاثة أصدقاء كتّاب، منهم رياض وطّار. وقد عادوا إلى مدنهم البعيدة، قبيل عيد الأضحى، فبقيت أعزلَ من المؤانسة والطعام.
كانت همهمات المصلّين تصلني من الأعلى، صبيحة العيد. وكنت أخاطب الرّئيس من الأسفل: "سوف لن تدخل التّاريخ ما لم تحرّر البلاد من الجوع الثقافي". افرنقعوا فقلت في نفسي: "سأقصد البحرَ، إن لم يكن للمناجاة فلكتابة قصيدةٍ". لا أذكر أنّني كرهتُ حياتي، مثلما كرهتها في تلك اللّحظة. لماذا لا نكتب عن اللّحظات التي كرهنا فيها الحياة؟
لماذا لا نكتب عن اللّحظات التي كرهنا فيها الحياة؟
نزلت السلّم المحاذي لقصر رياس البحر، في حيّ باب الوادي، فإذا بي أسمع وحوحاتٍ ذكوريةً، بما يدلّ على أنّ أحدهم مع إحداهنّ. وهو ما دفعني إلى أن أطلب من خطواتي ألا تفضحني، وأمنحَ أذنيّ لجهة الشّهوة.
اقرأ/ي أيضًا: أشياء على سطح الرواية
كان الفتى يستحضر، في خياله، فتاةً اسمها فاطمة. وعرفتُ من خلال مخاطبته لها، كأنّها في متناوله، صفاتِها وأفعالَها وعلاقتَه المتشنّجةَ بها. أنهى وهمَهُ الجسديَّ المقدّس، فتسلّلتُ إلى الشّاطئ، وأنا مدجّج بالجوع وبمعلوماتٍ كثيرةٍ عنهما. متمنّيًا أن ينضمّ إليّ هناك، وقد لمحتُ زوّادةَ طعامٍ يحملها بيسراه.
جلس الفتى على الرّمل، وأخرج من الزوّادةٍ العزيزة خبزًا وجبنًا ومشروبًا وتبغًا. أقصد ما كنتُ بحاجةٍ إليه تمامًا، فبيَّتُّ أن أشاركه إياه. سلّمتُ عليه، وطلبت منه سيجارةً، فأعطانيها بطريقةٍ أوحت لي بأنّه لا يرغب في التّواصل معي. ألقيت طعمي الأوّل: "ربّي يجمعك بمن تحب". استدار مخطوفًا: "آمين"، قالها بسرعةٍ وحرارةٍ لخّصتا لهفتَه إلى فتاته. قلت، وأنا أمنح عينيَّ للبحر: "ستجتمعان". قال: "كيف عرفت ذلك؟". ألقيت بالطعم الأكبر: "ألم تَعْنِ لك هذه الرّيشة شيئًا؟ إن شئتَ أخبرتك باسمها وبتفاصيل حياتها".
سردتُ عليه حكايتَه مع فاطمة، مستعينًا بما سمعته منه، وهو يستحضرها في خياله تحت السلّم. وبخيالي الذي تطوّع لمساعدتي على أن يتنازل لي طواعيةً عن بعض زاده، فراح يُطعمني بيده ويسقيني. وهي من العتبات الأولى، التي عرفت فيها كيف يُعانق الواقعُ الخيالَ في الكتابة الرّوائية، من غير أن ينفي أحدُهما آخرَه.
موت الرّاوي العليم
كان كورنيش وهران، ذات عشيّةٍ من صيف عام 2007، ضاجًّا بالحمام والبشر، الذين لا يراقب أحد منهم أحدًا. وكان فتًى لا يتجاوز العشرين يجلس على أحد مقاعد الكونيش، ويتأمّل البحر بعينين باكيتين في تصوّفٍ كبيرٍ، غير آبِهٍ بمن يغدو ويروح.
قلت له، وقد جعلت جلوسي إليه طبيعيًا: ما هذه الموسيقى التي تسمع؟ أعطاني الكتمان بحركة عفوية تشي بأنه لم ينزعجْ من فضولي، فهزّني الشّاب حسني بصوته الحي: "قعْ النّسَا اللي خلقهم ربي.../ ما يجونيش كاللّي بغاها قلبي". قلت وأنا أتأمّل البحرَ: كأنّه لم يمتْ رحمه الله. قال الفتى: وسوف لن يموت. قلت: لماذا في رأيك؟ قال: أنا كنت صغيرًا عندما قتلوه، لكنّني عندما كبرت وجدت أنّه كان يُغنّي للأشياء التي لا تنتهي في الإنسان، كان يغني للحبّ، في الوقت الذي كان فيه الإرهاب يحصد الأرواح. هل تعلم لماذا كنت أبكي؟
كنت صغيرًا عندما قتلوا الشاب حسني، وعندما كبرت وجدت أنّه كان يُغنّي للأشياء التي لا تنتهي في الإنسان
قرّبت الحكايةُ/ الجرحُ بيني وبين سفيان، فعشّاني في بيته، مع أمّه، وقد كنت مدعوًّا للعشاء مع أصدقاء يُدرّسون في الجامعة. ثمّ عرض علي أن يأخذني إلى مكانٍ وصفه بالمهبول، فوافقتُ على طول. تسرسب بي في حيٍّ عتيقٍ، ثمّ طرق بابًا لا يوحي بأنه شغّال، ففتح لنا بعد كلمة السر. سلام على الفتى الفاتح، وهو يرحّب بنا/ سلام على الفتية العشرة، الذين كانوا محلّقين في القبو، توجّسوا خيفةً من وجهي التلفزيوني، فأعطاهم سفيان غمزة الأمان/ سلام عليهم، وهم يتحلّقون حولي، ليلفظوا حكاياتهم دفعةً واحدة/ سلام علي، وأنا أنسّق بين الحكايات، فلا يفوتني منها خيط واحد. هناك كفرت بالرّاوي العليم في النصّ السّردي، حيث يرافق الشّخوصَ حتى إلى المرحاض، وقتلته تمامًا في روايتي "ندبة الهلالي".
اقرأ/ي أيضًا: مرتضى كزار.. الرواية ضرب من التأريخ
ما أن خرجت من القبو المحلّق، مصحوبًا بأسف "رواتي" على انسحابي المبكّر، حتى طلبني أصدقائي الجامعيون، وأمطروني بالعتاب على أنّني تركت طعامهم وشرابهم معلّقًا. التحقت بهم، فوجدتهم حزاني على ضياع سيّارة أحدهم. "خذوني إلى المكان الفلانيّ"/ قلت.
وجدت صعوبةً في العودة إلى القبو المحلّق، وفي إسكات الشّباب، وقد راحوا يرقصون فرحًا بعودتي، وفي القول إنّ سيارة رقمها كذا ضاعت من صديقي. اختلى سفيان بالفتيان مدّة ربع سيجارةٍ، ثمّ عاد إلي: هل تضمن لنا الأمان، فيجد صاحبُك سيّارتَه، صباحًا، في المكان الفلاني؟
اقرأ/ي أيضًا: