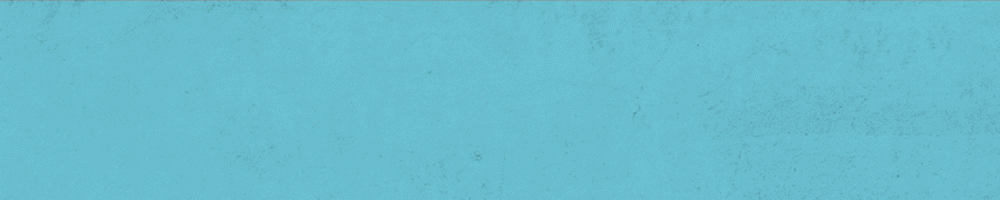هذه المادة مترجمة عن الأصل المنشورة في مجلة الإيكونوميست.
من مكاتبهم في وزارتي الخارجية الأمريكية والدفاع الروسية، يعكف المسؤولون على الاتصال ببعضهم كل بضع ساعات كي يتأكدوا أن الخطوط بينهم على خير ما يرام، ثم ما يلبث الصمت أن يسود بينهم في معظم الأحيان، وما هذه الاتصالات إلّا سكرات موت معاهدة الحد من الأسلحة النووية العالمية.
من المعروف أنّ التواصل المباشر بين مراكز الحد من الأخطار النووية (NRCS) لدى أكبر قوتين نوويتين في العالم ظل قائمًا حتى شهر آذار/مارس الفائت؛ إذ تبادل الطرفان رسائل مباشرة لإعلام بعضهما بحركة الصواريخ النووية والقاذفات. وسبق للطرفين أن وقّعا معاهدة ستارت الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2011، وتقتضي بنودها الالتزام بحدود قصوى من الأسلحة النووية بعيدة المدى. وبموجب هذه المعاهدة تبادل الطرفان كذلك نحو 2000 إخطار في عام 2022، بيد أنّ هذا التعاون توقف كليًا، وانقطعت التحديثات نصف السنوية لأعداد الرؤوس الحربية النووية، ولم تحصل أي عمليات تفتيش في المواقع منذ شهر آذار/مارس عام 2020.
وفي الوقت الراهن يلتزم البلدان بحدود المعاهدة بشأن أعداد الرؤوس الحربية، وهما إلى ذلك يتبادلان بموجب اتفاقية سابقة الإخطارات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية القادمة (وقد شهدت الأشهر الأخيرة تواصلًا محدودًا ورسائل قليلة بينهما). وما انفكّ الطرفان عن التواصل عبر قنوات منفصلة متعددة الأطراف مكرسة لتنفيذ عشرات الاتفاقيات الفردية التي تستلزم إخطارات متواصلة من مراكز الحد من الأخطار النووية.
وبصرف النظر عن الاتفاقيات والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يسعنا القول إنّ العالم على أعتاب سباق جديد للتسلح النووي، وهذا السباق يبدو مختلفًا عن السابق، فمن المحتمل أن يتعذر إيقافه مقارنة بنظيره خلال الحرب الباردة لأسباب ليس أدناها التعقيدات المتعلقة بالردع الثلاثي، والذي بات يتضمن الآن الصين. ويبدو أنّ شبح التهديد النووي يخيم على العالم في وقتنا الراهن، أو حسبما وصف أوبنهايمر- أبو القنبلة النووية- هذا الخطر في نهاية فيلم كريستوفر نولان- بأنه "سلسلة من التفاعلات التي توشك أن تُهلكَ العالم برمته".
شارفت هذه حقبة الهدوء على نهايتها لأربعة أسباب جوهرية؛ تتمثل في تخلّي الولايات المتحدة الأمريكية عن المعاهدات، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز الصين لترسانة الأسلحة النووية لديها والتكنولوجيا التدميرية.
ولا ريب أنّ نجاح الإنسانية في تفادي الإبادة يُعزى في المقام الأول إلى المعاهدات الكثيرة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقًا، وبينها وبين روسيا في الوقت الراهن؛ إذ حدّت تلك المعاهدات من الأسلحة النووية، ورسّخت الثقة بين الطرفين، وإنْ احتفظا بالأسلحة والوسائل الكفيلة بتدمير بعضهما. وقد تجلّت نتائج المعاهدات في انخفاض المخزون النووي العالمي من 70،400 رأس حربي عام 1986، إلى 12,500 رأس حربي اليوم.
ومع ذلك شارفت هذه الحقبة على نهايتها لأربعة أسباب جوهرية؛ تتمثل في تخلّي الولايات المتحدة الأمريكية عن المعاهدات، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز الصين لترسانة الأسلحة النووية لديها والتكنولوجيا التدميرية. ولو بدأنا بالولايات المتحدة الأمريكية، لرأينا أنّ الرئيس السابق، جورج دبليو يوش، قد انسحب عام 2002 من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (والتي كانت تحد من الدفاعات المضادة للصواريخ)، مشيرًا حينها إلى أن التهديدات المحتملة آنذاك تتجلى في كوريا الشمالية وإيران. وفي عام 2019 انسحب دونالد ترامب، وهو رئيس جمهوري آخر، من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (وهي التي كانت قد ألغت هذه الفئة من الصواريخ)، متحججًا آنذاك بانتهاك روسيا لبنودها وتنامي قوة الصين.
في المقابل بدا الرؤساء الديمقراطيين أحرص من الجمهوريين على الحدّ من هذه الأسلحة؛ إذ جرت المفاوضات لتوقيع معاهدة ستارت الجديدة أثناء رئاسة باراك أوباما، ثم جُدّدت هذه المعاهدة لخمس سنين في رئاسة جو بايدن عام 2021. وتنص هذه المعاهدة على تحديد عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية لكل بلد (المقصود هنا الأسلحة البعيدة المدى ذات القوة التدميرية الشديدة) بـ 1550 رأسًا حربيًا منشورًا، و700 صاروخ باليستي منشور عابر للقارات (تعرف اختصارًا بـ icbms)، وقاذفات وصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات.
ويقرّ مؤيدو معاهدة ستارت الجديدة بأوجه القصور فيها؛ إذ إنّها لا تحدد أعداد الأسلحة التكتيكية أو اللا استراتيجية، وهي الأسلحة الأصغر حجمًا المستخدمة في ساحات المعارك. ويوجد لدى روسيا نحو 1800 من تلك الأسلحة، في حين لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية إلّا 200 سلاحٍ فقط، ولا تتطرق المعاهدة أيضًا إلى الأنشطة الروسية في مجال تصنيع صواريخ كروز والطوربيدات العاملة جميعًا بالدفع النووي. وتشكو روسيا من جانبها من استبعاد الترسانات النووية لبريطانيا وفرنسا، حليفتي الولايات المتحدة الأمريكية اللتين تمتلكان ما يربو عن 200 رأس حربي لكل منهما. ومن المقرر أن تنتهي مدة معاهدة ستارت الجديدة في شهر فبراير عام 2026، في ظل الاحتمال الضئيل للتوافق على معاهدة لاحقة، وبذلك ربما يشهد العالم بعد ثلاثة سنين من الآن زوال آخر القيود المفروضة على المخزون النووي.
ومن هذا المنطلق يتأتى إلقاء اللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتهديداتها المتكررة باستخدام الأسلحة النووية؛ فمن المعلوم أنّ الدول الغربية عكفت على تسليح الجانب الأوكراني، بيد أنّها لم ترسل قواتها للقتال خشية نشوب حرب عالمية ثالثة وفقًا لبايدن. وفي شهر فبراير الفائت، أعلنت روسيا أنّها علّقت مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، وأوقفت تبادل الإخطارات مع الجانب الأمريكي، وسرعان ما حذت الولايات المتحدة الأمريكية حذوها في شهر يونيو الماضي. ومذّاك تراجعت الثقة بين الطرفين وتزايدت شكوك كل بلد بموقف الآخر، فتفاقمت لذلك سياسة حافة الهاوية النووية، لا سيما خلال الاضطرابات الداخلية التي عصفت بالكرملين؛ ففي 22 أغسطس من العام الحالي، أعلنت بولندا عن مباشرة روسيا نقل أسلحة تكتيكية إلى بيلاروسيا.
من جهة أخرى تبرز الصين ضمن العوامل التي تفاقم التهديد النووي العالمي، خاصةً أنّها تسارع الخطى نحو بناء قوتها النووية؛ فالصين غير ملزمة بالمعاهدات المبرمة بين أمريكا وروسيا، وهي إلى ذلك التزمت لوقت طويلٍ سياسة (الرّدع الأدنى) محتفظةً ببضع مئات من الرؤوس الحربية. بيد أنّ تقديرات البنتاغون تشير إلى ازدياد مخزونها الحربي باطراد حتى يبلغ 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، وهذا الرقم يناهز الحد الأقصى للرؤوس الحربية المسموح بنشرها حسب معاهدة ستارت الجديدة.
ولا شكّ أنّ هذه التوترات النووية قد تتفشى على نحو مفاجئ؛ إذ ربما تقرر الهند، التي تواجه نزاعًا حدوديًا عالقًا مع الصين، زيادة مخزون أسلحتها الذي يقدر حاليًا بأكثر من 160 رأسًا حربيًا، وقد يحدو هذا الأمر بباكستان- التي تمتلك عددًا مماثلًا من الرؤوس الحربية- إلى تعزيز قدراتها العسكرية. ولا تكفّ كوريا الشمالية- التي تمتلك 30 رأسًا حربيًا- عن اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، أما إيران فيتأتى القول إنها على أعتاب التحول إلى دولة نووية عمّا قريب.
ولا يسعنا كذلك أن نغفل عن دور التكنولوجيا الحديثة في تأزيم الأمور على الصعيد العالمي؛ فعلى سبيل المثال يتعذر اكتشاف وإسقاط الصواريخ الفرط صوتية مقارنة بالصواريخ الباليستية، كذلك تُفاقِم التحسينات المطردة على مستشعرات الصواريخ ودقتها المخاوف بشأن التصدي للهجمات الصاروخية المباغتة. ولا ريب أنّ انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات كثيرة بشأن دور أجهزة الكومبيوتر في مجريات الحرب النووية.
ولم تقف الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات كلّها، فأخذت تشهر سلاحها النووي، بل وتستعرضه أمام أنظار الجميع؛ فغواصاتها الحاملة للصواريخ الباليستية باشرت الظهور في أماكن متفرقة من العالم بعدما اعتادت سابقًا أنّ تتوارى عن الأنظار في دوريات تستغرق أحيانًا شهورًا بأكملها. وفي شهر تموز/يوليو الفائت، رست الغواصة الأمريكية يو إس إس كنتاكي في ميناء بوسان بكوريا الجنوبية، في حين رست الغواصة يو إس إس تينيسي في ميناء فاسلين الأسكتلندي. وفي شهر أيار/مايو الماضي انطلق كبار القادة البحريين من اليابان وكوريا الجنوبية على متن الغواصة يو إس إس مين قبالة جزيرة جوام، أما في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، فظهرت الغواصة يو إس إس وست فرجينيا في بحر العرب حاملة على متنها رئيس القيادة المركزية الأمريكية، وهو ما يعد رسالة مباشرة إلى إيران.
وبناء على هذه التحركات انتفت السرية عن المهام الموكلة لتلك الغواصات، وفي هذا الصدد يقول الأدميرال البحري جيفري جابلون، قائد قوة الغواصات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لموقع بريكينج ديفينس (Breaking Defense): "لا يسعك التعويل على قوة رادعة موثوقة دون الكشف عن قدراتك العسكرية، فإنْ جَهِل الخصم مدى قدراتك الرادعة، فعندئذ لن تردعه عن مهاجمتك".
ولا ريب أنّ أمريكا تريد بتحركاتها هذه طمأنة حلفائها بشأن قوة سياسة (الردع الموسع) التي تنتهجها، والمقصود بها التعهد بالدفاع عنهم في وجه الهجوم النووي، وإن نبذوا استخدام الأسلحة النووية. وينادي كثيرون في بولندا وكوريا الجنوبية بأن تخزن أمريكا قنابل الجاذبية النووية b61 في أراضي البلدين، بيد أنها امتنعت عن ذلك. ويبقى الظهور المتفرق للغواصات الأمريكية بمنزلة تحذير للأعداء وطمأنة للأصدقاء.
وتعكف الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا على تحديث العناصر الثلاثة لثالوثها النووي بأنظمة برية وبحرية وجوية متطورة وجديدة، ولعلّ الهدف الخفي لهذه الأنشطة هو تعزيز القاعدة الصناعية النووية بما يكفل إنتاج أسلحة أكثر في المستقبل عند اللزوم. ويرى بعض المراقبين أنّ الأمر يتعدى هذا الغرض؛ ففي ورقة بحثية أجراها مختبر لورانس ليفرمور الوطني في شهر آذار/مارس الفائت- وهو معهد ممول من الحكومة يتولى مهام كثيرة منها تصميم الرؤوس الحربية النووية- يصف الباحثون القوة النووية الحالية لأمريكا بـ (الكفاية الحدّية)، فلا بدّ لها من توسيع قوتها بحلول نهاية معاهدة ستارت الجديدة، فعليها مثلًا انتهاج سياسة التحميل السريع، ونشر الأسلحة المخزنة حاليًا، مثل تحميل الرؤوس الحربية المتعددة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ويتعين عليها قبلها أن تبرهن عن كفاءتها وقدرتها على القيام بذلك.
وتتميز أمريكا عن روسيا بقدرة تحميل تفوقها بكثير؛ إذ تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين- الذي يطلق حملات رامية للحد من الأخطار العالمية- إلى أنّ الإجمالي الحالي للرؤوس الحربية الاستراتيجية التي نشرها كل بلد منهما يناهز 1670 رأسًا حربيًا (اعتمد العلماء قواعد حسابية مغايرة لتلك المستخدمة في معاهدة ستارت الجديدة)، غير أنّ أمريكا تستطيع أن تنشر 3570 رأسًا حربيًا في غضون عامين مقارنة بـ 2629 لروسيا. ويساور الخبراء قلق شديد من استئناف القوى الكبرى عمليات الاختبار للأسلحة النووية، وهو أمر سبق نقاشه في رئاسة ترامب.
الواقع يقول إنّ التكافؤ هو المبدأ الذي قامت عليه سياسة ضبط التسلح بين أمريكا وروسيا، بيد أنّ التوافق على هذه المسألة بات متعذرًا بعدما أصبح الأمر منوطًا بأطراف ثلاثة.
وسبق لجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تطرق في معرض حديثه عن الانعطاف في التوازن النووي، إلى استعداد أمريكا لمناقشة مسألة الحد من الأسلحة مع روسيا والصين، دون أي شروط مسبقة. ولم يتعجل الطرفان قبول هذا العرض؛ فروسيا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في أوكرانيا إما تضررت قواها العسكرية بشدة، وإما تعوّل تعويلًا كليًا على الأسلحة النووية لحدّ يتعذر عليها التفكير في اتفاق جديد. أما الصين فليست مكترثة بوضع أي حدود على هذه الأسلحة، ربما حتى تبلغ مستوى التكافؤ مع أمريكا.
والواقع يقول إنّ التكافؤ هو المبدأ الذي قامت عليه سياسة ضبط التسلح بين أمريكا وروسيا، بيد أنّ التوافق على هذه المسألة بات متعذرًا بعدما أصبح الأمر منوطًا بأطراف ثلاثة. ولا بد أن الولايات المتحدة تخشى تحديدًا من أن تتحالف الصين وروسيا ضدها، قياسًا على إعلانهما المشترك عن صداقة بلا حدود بين البلدين، وتنفيذهما دوريات جوية وبحرية مشتركة. ويصرّ سوليفان أن أمريكا ليست ملزمة "بالتفوق على مجموع منافسيها بالعدّة" حتى تردعهم، لكن ربما لا سبيل لمقاومة الضغط المتزايد على أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية وزيادتها حسبما يقول جيمس أكتون، من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية أمريكية. وطالما أن سياسة الاستهداف الأمريكية قائمة على (القوة المضادة)، أي توجيه أسلحتها النووية صوب المواقع النووية للطرف الآخر لتحييدها- فلا شك أن ازدياد عدد تلك الأسلحة لدى المنافسين يقتضي حاجة الولايات المتحدة إلى أعداد متزايدة منها.
مُهلِك العالم
ويشرح إريك إيدلمان، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة في عهد جورج بوش، هذه المسألة شرحًا مغايرًا، فهو إلى ذلك يستحضر حسابات الحرب الباردة بشأن قدرة استيعاب الضربة الأولى، ومواصلة إلحاق أضرار فادحة بالعدو، فيقول: "إذا كان لديك خصمان بحوزة كلّ منهما 1500 سلاح نووي، ثم قصفك أحدهما بأسلحته فنجوت منه ورددت له الصاع صاعين، فماذا بقي عندك من أسلحة احتياطية تواجه بها الخصم الآخر؟". ويردف إيدلمان: "لا ندري حقًا ما عدد الأسلحة الدقيق، لكنه يتعدى 1550 سلاحًا على الأرجح".
ولمّا كانت التوقعات ضئيلة بشأن احتمال التوافق على معاهدات جديدة للحد من الأسلحة النووية، فلا شكّ أن أمريكا تدرس ترتيبات أقلّ رسمية مع الصين تحسبًا لتحول الأزمات إلى صراع. وهنا اقترح سوليفان توسيع نظام خطوط التواصل الساخنة والإخطارات القائم مع روسيا، على أن يشمل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيد أنّ الرد الصيني جاء محبطًا. ويلخص سوليفان هذه المسألة بقوله: "إن وضعت حزام الأمان في أثناء قيادة السيارة، فسترغب بقيادتها بسرعة أكبر وأكثر جموحًا، وربما تتعرض لحادث تصادم جرّاء ذلك، لذلك يستحسن بك أصلًا ألا تقيّد نفسك بحزام الأمان".
في المقابل تبقى مسألة الذكاء الاصطناعي وضبط استخدامه أصعب الأمور، خاصة أنه ليس شيئًا ماديًا خاضعًا للمعاينة أو الحساب مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وحتى لو ساهم الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، فقد ضغطت أمريكا وبريطانيا وفرنسا لوضع قاعدة تقتضي (وجود الإنسان دومًا في دائرة اتخاذ القرار) حينما يرتبط الأمر باستخدام الأسلحة النووية.
ولو تطرقنا مجددًا لشؤون وزارة الخارجية، لرأينا مراكز الحد من الأخطار النووية تمارس أعمالها بكامل قوامها من الموظفين، خاصة في ظل وجود 40 شخصًا مكلفين بإدارة خطوط التواصل أملًا بتحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو؛ فالمتحدث الروسي متاح طوال الوقت، ولا بدّ من وجود متحدث صيني لو طغت الحكمة على عالمنا. ولو عدنا إلى السينما لوجدنا أوبنهايمر يقول في الفيلم إنه "منح الناس القدرة على إفناء أنفسهم"، ومن هنا يتأتى لنا التساؤل إن كانت البشرية قادرة على إنقاذ نفسها من أتون الكوابيس النووية الجديدة.