هل يمكن للجامعةِ أن تَقتُل؟ لم يطرح الدّكتور عزّالدين شكري فشير هذا السّؤال بشكل صريح في روايته "جريمة في الجامعة"، إلّا أنّ أصداء السّؤال تردّدت في جنبات الحوارات التّي دارت بين شخصيّات الرّواية في أجزائها السّبعة. بعيداً عن الكليشيهات العصرية التّي يحتملها الرّبط بين العمل والأذى المترتّب عن تجاوزه حدود المعقول، فإنّ السّؤال الذّي تطرحه الرّواية لا يرمي بالاً لسرديّة التّنمية البشريّة التّي تسوّق لهذا الرّبط. السّؤال هنا -بالأحرى- سرياليّ بطبيعته بحيث يتكهّن إمكانيّة أن تكون الجامعة فعلاً متورّطة بالقتل لا كفعل مجازيّ، بل بالمعنى العنيف لفعل القتل الحقيقيّ؛ أي ذاك المرتبط بطعنٍ أو خنقٍ أو تسميمٍ أو حقنٍ أو رميٍ بالرّصاص كفيلٌ بسلب أحدهم حياته.
ينسج الكاتب شخصيّات روايته من وحي تجربته. لا يصعب على القرّاء ممّن جرّبوا العمل الأكاديميّ في نطاق الجامعة إدراك تجربة الكاتب كأستاذ جامعيّ. بالنسبة لي مثلاً، فلم ألبث أن ولجت قليلاً في شخوص الرّواية حتّى تكشّفت لي محاكاة هذه الشّخصيّات للواقع الذّي أعيشه كأستاذة جامعيّة. حتّى أنّي ومن خلال قراءتي للرّواية كنت كثيراً ما أقرن رغباتي وآمالي وحتّى مشاكلي بتلك التّي مرّت بها عدد من الشّخصيات. ويتجلّى هنا السّؤال الأهمّ؛ ما هي سمات واقعنا الذّي يجعل من احتماليّة هذا التشابه ممكنة؟
الجامعة كمسرح القسوة
في كشف كاتبنا عن مسرح الجريمة التّي تقع ضحيّتها أستاذة جامعيّة كثير من القسوة. فعلى الرّغم من الإشارة إلى هذه القسوة في العنوان الذّي تحمله الرّواية، إلّا أنّ المشهد الأساسيّ حيثُ تُوجد القتيلة يفوق كلّ التّوقّعات. تكمن غرابة المشهد لا بوصفه فقط، بل في موقعه؛ مكتبها في الجامعة! تجد الضّحيّةَ واحدةٌ من زميلاتها:
"كانت يارا جالسةً خلف مكتبها، ونصفها الأعلى ملقى على المكتب كأنّها نائمةٌ عليه، عارٍ إلّا من حمّالة صدرها، وذراعها اليمنى ممدّة على سطح المكتب بإهمال والثّانية مختفية وراءه. خد يارا الأيسر ملتصق بسطح المكتب ونظرة فارغة تطلّ من عينها اليمنى، بينما فمها المفتوح يسيل منه الدّم". ص٤١.
تزداد قسوة المشهد حين نقترب من جسد يارا. يصف كاتبنا مسرح الجريمة مفصّلاً ويقول:
"الضحية ضئيلة الجسم، تلقت طلقة في الرأس، واضح أنها استقرت في الجمجمة. كما تلقت طعنة في بطنها لا تزال تنزف. وعلى رقبتها علامات خنق وكدمات في الوجه. ثم هناك قميصها المخلوع ملقى بإهمال في زاوية بالمكتب. بجوار رأس الضحية هنا زجاجة نبيذ مفتوحة لكنها شبه ممتلئة، وبقايا نبيذ في كأس مكسورة وملقى الجزء الأكبر منها على سطح المكتب وبجوارها بقع تبدو أنّها بقايا نبيذ أيضاً". ص٤٩.
ربّما هي ذات القسوة التّي يطرحها أنتونين آرتاد في نموذجه المسرحيّ. في نظريتّه، مسرح القسوة، يبدّد آرتاد العلاقة الاعتياديّة بين الممثّل والمشاهد من خلال إلغاء الحدود الفراغيّة التّي ترسم المسافة بين الأداء والحضور. يدعو آرتاد بالمقابل إلى تكثيف تجربة المشاهد الحسّيّة. في التّجارب المسرحية الأولى حيث طرح نموذج مسرح القسوة، تمثّل هذا التكثيف بمداخلات ضوئيّة وصوتيّة عصفت بتجربة المشاهد الاعتياديّة كمتفرّج بعيد. بالنسبة لنا كمشاهدين، يشدّ مسرح القسوة حواسّنا مطالباً إيّانا مبارحة السّلبيّة التّي تفترضها حاسّة البصر نزولاً عند حاجتنا للتبصّر، وكأنّنا بذلك نجيب عن سؤال: لماذا نحسّ ما نحسّ؟ وكيف نتصرّف إزاءه؟
تكمن القسوة في مشهد الجريمة الذّي يصفه الكاتب في قدرته على اقتحام فضائنا الحسّيّ وزحزحتنا عن مواقع لطالما جالسناها مرتاحين مطمئنين؛ كيف تُقتل أستاذةٌ جامعيّة بهذه الوحشيّة في مكتبها في الجامعة وهي المؤسّسة الأكثر رقيٍّا من بين كلّ المؤسّسات؟ ولماذا تُقتل هذا العدد من المرّات؟ نقف أمام العنف الذّي ينمّ عنه المشهد وقوف المحقّق أمامه؛ مشدوهين بسرياليّته. يتدارك المحقّق حقيقة دهشته حينما تبدأ رئيسة الجامعة بمفاوضته على النّتائج التّي يمكن أن يترتّب عليها تحقيقه وبتبريرها ما تمكره بحجّة سمعة الجامعة. بعزيمة المبتدئين كان عليه أن يبدّد حصانة الأكاديميّين الأخلاقيّة التّي غشّت مخيّلته الغشيمة حتّى يتتبّع الخيوط التّي لغزت مشهد الجريمة.
الجامعة كحاوية
لا بدّ للمحقّق أن يفهم نوع العلاقات التّي تربط منتسبي الجامعة من إداريّين وأكاديميّين وطلّاب ببعضهم البعض. ذاك الفهم منوط بإدراكه السّياسات التّي يحتكم إليها موظّفو الجامعة والتّي تشكّل رغباتهم ودوافعهم في ظلّ المؤسّسة الجامعيّة على اختلاف منازلهم. يختار الكاتب قسم دراسات الشّرق الأوسط داخل حرم الجامعة الأمريكيّة كبيئة نفهم من خلالها نشأة هذه العلاقات وتطوّرها. ما هي العوامل المؤثرة على تشكّل هذه العلاقات؟ كيف يشقّ كلّ أكاديميّ موقعه عبر المؤسّسة الجامعية؟ وكيف يحافظ الأكاديميّ على موقعه في المؤسّسة؟ كلّها أسئلةٌ ضروريّة لفهم الميزان الذي تكال به علاقات القوى في السياق الجامعيّ، وما يترتّب عليها إذا ما طفح بأحدهم الكيل.
كانت الرسائل التّي تبادلتها المجنيّ عليها عبر بريدها الالكتروني مع زملائها من نفس القسم هي أوّل الخيوط التَي بدأ المحقّق بتتبّع أثرها للكشف عن المستور. في أوساط مؤسّسيّة ذات سمةٍ حداثيّة، يُعاملُ البريد الالكترونيّ معاملة الوثيقة الرّسميّةً. وبصفته تلك، تكون الرسائل الصادرة عنه والواردة إليه بمثابة أدلّة يتتبّع من خلالها علاقات الموظّفين حال حدوث تحقيق أيّاً كانت دواعيه. مثلاً، إذا ما تقدّم أحدهم بشكوى ضدّ زميله، يعامل صندوق البريد الوارد لكل منهما معاملةَ الأرشيف. في واحدةٍ من الرسائل الصادرة من بريد المجنيّ عليها، تواجه د. يارا رئيس القسم فتقول بانفعال:
"... تحمّلتك وأنت تلهث خلف التّمويل الأجنبيّ وتحملتك وأنت تهاجم المموّلين حين انصرفوا عنك وتتهم من خلفوك في تلقي المال منهم بالعمالة. تحملتك وأنت تهدّدني بوظيفتي إن عارضتك وتحملتك وأنت تدّعي رعايتي وأبوتي الرّوحية. تحملتك وأنت تتخلص من كل زميل أو زميلة فيهم الرمق، وتحملتك وأنت تشتكي من تدني المستوى. تحملتك وأنت تهدّدني بتدمير مستقبلي إن حاولت العمل بمكان آخر، وتحملتك وأنت تمنّ عليّ بوظيفتي في القسم. تحملتك وأنت توجه عملي دون أن تعرف عنه شيئاً. تحملتك وأنت تستغلني لمساعدتك وكتابة الأبحاث التي توقعها باسمك، ثم تحملتك وأنت تلومني على عدم اهتمامي بالبحث والنشر.." ص٩٠.
وفي واحدة من الرّدود التّي تصل إلى يارا من رئيس القسم، يقول:
"كفي عن هذا العبث، أنت لست مراهقة الآن. وتعرفين جيّداً أنّ هذه الجامعة عبارة عن مزبلة كبيرة، كل شخص يجمع لنفسه كومة منها ويجلس فوقها، وهذا القسم كومتي، وبدوني لن يكون له وجود. كلّ هذا الوقت وأنا أحميك وأنت تشتكين ..." ص٩٣.
تزامن التّحقيق في المراسلات التّي حدثت بين يارا وزملائها في القسم -سواء عبر الإيميلات أو عبر تطبيقات المراسلة في هاتفها المحمول- مع التّحقيق الجنائيّ في الأدلّة التّي كشف عنها مشهد الجريمة والتّي جسّدت آثارها الكدمات والطّعنات على جسم د. يارا. ومع استمرار التّحقيقات كانت تتّسع دائرة المشتبه بهم ممّن وطئوا مشهد الجريمة حتّى ضمّت أخيراً كلّ من تواجد في القسم بعد انتهاء الدوام حيث اجتمعوا لحضور تنسيقية كان قد رتب لها رئيس القسم.
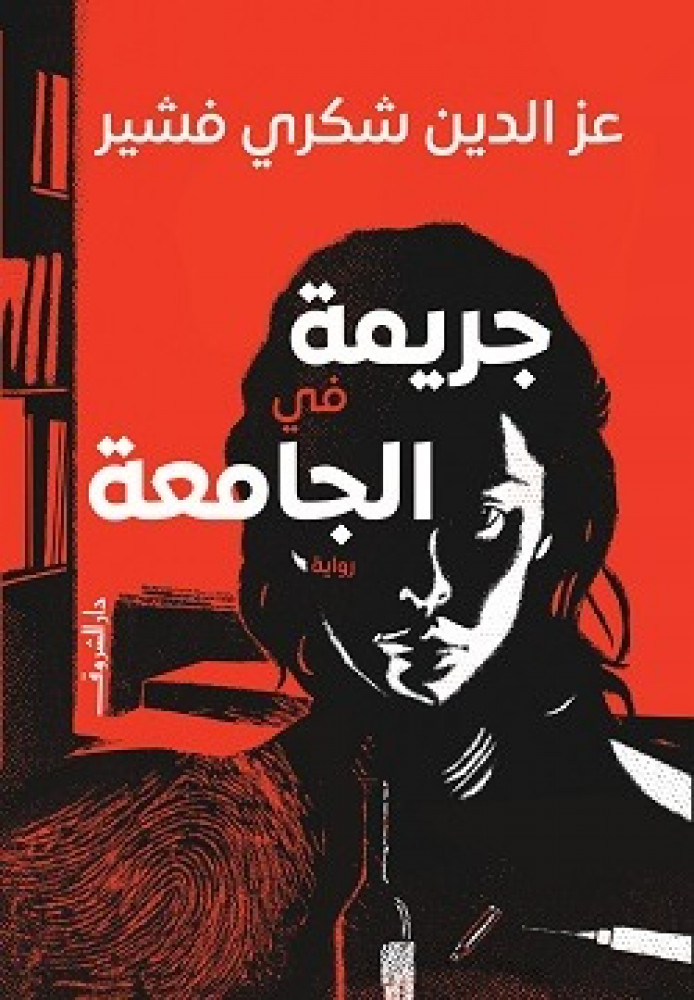
تقاذف المشتبه بهم التّهم؛ كلّ يلقف التّهمة التّي تكاد أن تصيبه على زميله. لم يجتمع أيّ من الأساتذة على روايةٍ واحدة، إلّا أنّهم اتّفقوا على اعتياديّة هذه البذاءة في المراسلات حينما ووجهوا بها. يقف المحقّق أمام هذه البذاءة مذهولاً. فإنّه وإن استطاع أن يبدّد الحصانة الأخلاقيّة التّي يتدرّع بها الأكاديميّون، إلّا أنّه لم يستطع أن يفهم درجة الانحطاط التّي استمرّ تحقيقه بالكشف عنها. فهذا الانحطاط يتناقض وتمثّلاتهم الطّبقيّة التّي يدّعونها كبرجوازيّين. هذا الكرّ والفرّ بين الدّليل وبطلانه زاد المشهد إبهاماً ممّا عطّل على المحقّق إمكانيّة لملمة الأمور. كلّ من تواجد في القسم وقت الجريمة -من أساتذة وطلّاب- هم مشتبهٌ بهم حقيقيّون. كلّ عنده من الأسباب ما يسوّل له الدّافع لقتل د. يارا.
الجامعة كفاعل
من بين التّفسيرات التّي احتملها المشهد هو أن تكون د. يارا قد أقدمت على "الانتحار". في استغرابه من الطّرح، يردّ المحقّق على هذا الطرح في بداية التّحقيقات ساخراً، "انتحار إيه ..؟ في حد بيعمل في نفسه الحفلة دي عشان ينتحر؟ ليه هتضرب نفسها بسكّينة وبعدين بالنار؟ ده زي اللي انتحر بثلاث رصاصات في المخّ؟" ص٥٤. وعلى الرّغم من هشاشة الانتحار كفرضيّة، ومن غرابة الطّرح ارتباطاً بالحالة التّي وجدت عليها د. يارا، كان يتصدّر الانتحار قائمة الفرضيات في كلّ مرّة كان يُطرح بها. فكلّما وصلت التّحقيقات إلى منعطف كاشف خطير، لاح "الانتحار" في أفق رئيسة الجامعة. في تبريرها لرغبة رئيسة الجامعة، تقول سكرتيرتها للمحقّق:
"إن هم الجامعة الرئيسي هو احتواء الموضوع وتقليل الشّوشرة والنتائج السلبيّة للحادث بأكبر درجة ممكنة. هذا هو السبب في دفعهم المستمر لفرضيّة الانتحار؛ فانتحار أستاذة شيء مأساويّ لكنها كان لديها مشاكل مثبتة في الورق، ومن ثمّ فهي مأساة شخصية لا تنعكس سلباً على الجامعة. أمّا قتل أحد الأساتذة لزميلة-أو الشروع في قتلها- فهو أكبر من مجرّد مأساة شخصيّة لإنسانة مضطربة" (ص٢٢٩).
ولنفترض أنّ د. يارا قد انتحرت فعلاً، فهل يكون انتحارها، واضطرابها من قبل ذلك مآسٍ شخصيّةً حقّاً؟ إنّ ما كشفت عنه التّحقيقات خلال صفحات الرّواية يؤكّد أنّ هذه المرّة هي ليست المرّة الأولى التّي تقتل بها د. يارا. فقد قتلت من قبل ذلك ألف مرّة. حين تحرّش بها أستاذها وهي طالبة، وحين تزوّج صديقتها بعد أن كان قد وعدها بالزّواج. وحين كُذّبت واتّهمت بالاضطراب بعد مشاركتها تجربتها. وحين جوبهت بحرب طاحنة تخوّنها وتطعن في نزاهتها الأكاديميّة بعد سنين من عملها الدّؤوب للسّعي خلف شغفها الأكاديميّ. وحين اكتشفت أنّ زميلها (المتحرّش) ذا الشّعبيّة كان قد بنى أمجاده الأكاديميّة على بحوث مسروقة. وحين اضطرّت أن تتعامل مع زميلتها المخبرة التّي كانت تتحيّن الفرص للإيقاع بمن فيهم الرّمق. وأخيراً حينما أيقنت أنّ ما مرّت به ليس مجرّد حالةً خاصّة بل عجلةٌ تدور لا يوقفها الزّمن.
إذا ما فكّرنا بما مرّت به المجنيّ عليها من قبل، ستزداد واقعيّة المشهد وتنقص سرياليّته لنستنتج أنّ الكاتب لم يقدّم مشهداً مغايراً للواقع. نعم، يمكن للجامعة أن تقتل. هو واقع مقنّع بكثير من الفضيلة. لكنّه لم يكن ليحتفظ بقناعه هذا دون ادّعائنا نحن العامّة بأنّنا لا نرى. فيكون الفرق بين الجريمة هنا وما مرّت به المجنيّ عليها من قبل، هي مرئيّة العنف على جسدها. إنّ فرضيّة الانتحار لم تكن لتطرح كمخرج لولا القصور القانونيّ الذّي تعاني منها ثقافة المؤسّسة القضائيّة التّي تلوم الفرد على مشاكله وعلى اضطرابه وعلى مآسيه. ما بالكم لو كان هذا الفرد مختلفاً وبسبب ذلك الاختلاف استثنته ضمائرنا، لأيّ سبب كان؛ سواء كان ذلك بسبب جندره، أو دينه، أو عمره، أو طبقته، أو جنسيّته؟
تحرم فرضيّة الانتحار المجنيّ عليها من حقّها في تعريف الجاني. تحمّلها -بكلّ فجاجةٍ- مسؤوليّة موتها. وكأنّ الجامعة لا تكتفي بسلب د. يارا حياتها بل تجرّدها من إمكانيّة أن تذكر بعد موتها. بالنّسبة للمحقّق، فإنّ بناء فاعل الجريمة إلى المجهول هو أمر خطير؛ جريمة يرتكبها بحقّ ضميره اليقظ. وما بين الخلوص إلى نتائج تحقيق مزوّرة يكسب بها الجميع، وما بين الكشف عن قاتل د. يارا الحقيقيّ لا يحتار المحقّق كثيراً.

