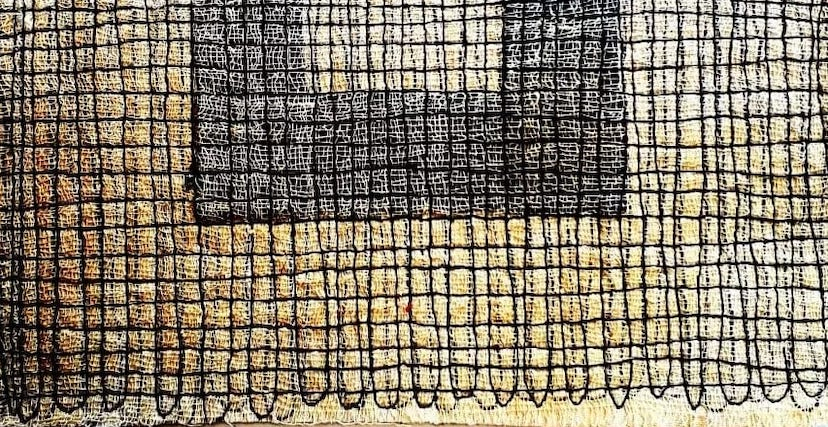في عالمنا الحالي، حيث الوقت سائل والحاضر لا يصمد أمام مدارات السرعة ليصير ماضيًا، وحيث السلطات عاتية في فرضها سبل العيش علينا، يتعرض الشعر كفضاء لغوي يصنع منه الشاعر مساحة عرض رديفة للواقع لامتحان في الصمود أمام هذه الضغوطات. فإذا كان الشعر في أصله هو تحايل لغوي على الواقع فإن هذا التحايل يبدو الآن ضعيفًا ولا يصمد أمام عسف الحياة هذه وازدرائها. فمع أهوال الموت واستحالات النهوض، ونكوص التطلعات الخلاصية، والانخسافات المتتالية في مستويات الإدراك الفردية والجماعية، تصبح اللحظة الشعرية برهة ثقيلة ومتكلفة في زمن اللغة.
يعجز الشعر أن يصنع قولًا جديدًا في الحاضر والمستقبل، ويعجز عن بناء أصوات تؤسس لتصورات تلمس الذات وتقول في الحياة ما يُعرِّفها، فتبدو الجمل الشعرية كفائض لا مكان فيه لليومي والمعاش
وهذا ما يضع الشعر على سمت من الأصولية في مبتغاه ووظيفته، كأن تتحول القصيدة إلى ما يشبه أغاني أم كلثوم، طرب وإعادة تدوير لأحاسيس ولحظات كلاسيكية توغل في توسل رومانسي منقطع عن لحظة ومكان التقاط هذه اللحظة. وهذا تقليد في استراتيجية صناعة اللحظة الشعرية لا يؤسس للحظة تالية تأتي فيما بعد، أي أنه يصبح مساحة وقت لا قول، ما يسمح للجمل الشعرية بالإقامة في ثقب الوقت، في طية الزمن، مبعثرة بين لحظتي "ليس الآن" و"ولم يعد ممكنًا" خلافًا للحظة التي يريد الشاعر التقاطها في "هنا" و"الآن" الراهنتين التي يريد الشاعر أن يرفعهما إلى رتبة الزمن.
وفي هذا يعجز الشعر أن يصنع قولًا جديدًا في الحاضر والمستقبل، ويعجز عن بناء أصوات تؤسس لتصورات تلمس الذات وتقول في الحياة ما يُعرِّفها، فتبدو الجمل الشعرية كفائض لا مكان فيه لليومي والمعاش. فإذا كانت اللحظة الشعرية هي عملية إطالة للوقت وتضخيم للشعور وأسطرة للحظة ورفع المقصد إلى مصافي "الإنساني" و"العام" والكوني". فإن الجمل الشعرية هذه تبدو كأنها تأتي من زمن مختلف لا تتجانس مع الموقع الذي انطلق منه الشاعر ولا ترقى إلى ما يصبو إليه. فالراهن الذي نقيم فيه هو زمن مصنوع من الاستعارات، ومؤسطر بكثافة ميديائية عالية، ومسيج بسياسات الصوابية والشعبوية في آن. وأجسادنا هي آلات تقنية تسير في أحياز العمل الهلامي الممزوج بالترقب والعزلات. وعلى هذا تبدو رفعة الشعر في هذا التكثيف المضاعف قادمة من خصائص موروثة ككعب آخيل المزين بحذاء فيرساتشي.
وفي هذه الرومنسية يصبح الشعر كالأحلام. أحلام تبشيرية تأخذ من مخزون الانطباع وانساق صناعته وسلالم الترميز الموروثة، وتصنع منها أدوات، تبدو كأنها تتغنى بزمن وتوظف صورًا ليست من زمن القصيدة الفعلي. وهذا ما يجعل الشعر يقيم خارج عملية توزيع الأحاسيس وتشاركها، في ما يشبه عملية الهروب بالشعر، عوضًا أن يكون الإحساس ممرًا في الشعر وعبره. وبهذا يعجز هذا الشعر عن الاستثمار في براغماتية التعامل مع الواقع، فيغرق في تمجيد الماضي وبناء التخيلات واستمداد الأنساق والجمل والرموز من تجارب سابقة صارت تقيم في متحف الشعر وليس في متنه. وبهذا يصبح الشعر أداة صناعة نوستالجية، ومحاولة تأسيس أمل على ماض كنا قد أصَّلناه بأسطرة في مخيلتنا، ونظن أنه يملك من الجدارة ما يمكّننا أن نعيده إلى مستقبلنا هربًا من واقع مبهم وعات، أكان هذا الماضي حياة سابقة أم انساقًا شعرية عملت فيه وطبعته ومثلته في وعينا. وفي هذا يتمحور جهد الشاعر في صناعة قصيدته لتثبيت كينونة الشعر بدلًا من أن ينتج شعرًا يقول.
على الرغم من أن الرومانسية في الشعر، بمعناها العريض، توضح الآلام والعذابات إلا أنها في المقابل تستخف بهذه الآلام بإحالتها إلى انطباع مضخم، يتسارع انتفاخه للاتصال بالنمط الذي يُخرج من خلاله الشعر من الواقع ويدفعه للعيش في هذه الأحلام. وعليه يبادرنا سؤال بديهي، كيف يمكننا أن نكتب شعرًا دون أن نكون أنبياء. ففي زمننا هذا بات الموت في مصاف العادي وأصوات الموتى أو من ينعونهم يبدو أيضًا باهتًا وهزيلًا. ويبدو أن الشعرية التاريخية المرافقة للموت كحدث درامي وتراجيدي صارت بخارًا، ولم تعد تستطيع أن تضع الموت في خانة "الشرط الإنساني"، فسهولة حدوث الموت واضمحلال أهميته المفجعة، وسرعة تلاشي أثره تجعله يختفي ويذوب، أي لا يؤسس للحظات توقف أو لإمكان الحداد والتذكر. وهو بهذا يصير خفيفًا تمامًا، كالأكل والشرب والتغوط، شيئًا خاصًا لا تتوقف عنده الحياة للتفكر.
كيف يمكننا أن نكتب شعرًا في الواقع وعنه دون أن نركن لقيم كونية صافية في مثاليتها، صارت الفجوة في الوصول إليها عميقة مع غياب التصورات وسيطرة العلم على حياتنا ومسلكنا وتعبنا؟
كيف يمكننا أن نكتب شعرًا في الواقع وعنه دون أن نركن لقيم كونية صافية في مثاليتها، صارت الفجوة في الوصول إليها عميقة مع غياب التصورات وسيطرة العلم على حياتنا ومسلكنا وتعبنا؟ كيف لنا أن نكتب شعرًا عن أحلام مؤقتة في دوام الحاضر وسطوة عبثيته وعشوائيته، دون معاودة بناء يوتوبيات في الشعر. كيف يمكننا أن نترك الحصان وقهوة الصباح في رفوف المكتبة؟ كيف يمكننا أن ننزع عن البحر والنهر صفات الطبيعة وعن المطر صفة البركة، وعن الموسيقى سمة الأفق الذي يمكننا أن نقيم فيه خارج العزلة؟ كيف يمكننا أن نُعرِّف جسدنا بعيدًا عن الجسد الجاهز والحاضر في فتنته وحميميته ونحن متعبون؟ وكيف يمكننا أن ننزع عن التاريخ هالته بوصفه معركة لتصحيح خلل وصانع احتمالات؟ كيف لنا أن نرى المدن بؤر تلوث والمواقع الأثرية حمولات زائدة عن قدرتنا في الاعتناء بها؟ كيف لنا أن ندفن شعر الثورة والجنس العابر بين المعارك؟ كيف لنا أن نقول إن هذا الشعر ولغته ورموزه وتصوراته هي مواد متحفية؟ كيف نستطيع أن ننزع عن الشعر وأدواته صفة النبوة وهو الذي لطالما كان أداة أسطرة اللحظات، لإعطائها حيزًا في الذاكرة وتقديمها كسلاح ضد النسيان.. وهذا كله مما يبدو عكس منطق الشعر ذاته؟