تكتب ابتسام عازم لتصف الحياة الاجتماعية للفلسطينيين في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، ولتبيّن قدرة الذاكرة، بوصفها حبل النجاة الأخير، على المحافظة عمّا يسعى الإسرائيليون إلى طمسه وتشويهه. لكنّها في الوقت نفسه، تتجنّب الاستسهال في الذاكرة والنوستالجيا، ولا تمدّ رواياتها بأبطال كلاسيكيين حضروا في المدونة الأدبية الفلسطينية المعاصرة بكثرة، مكتفيةً بكسر ما يمكن تسميته بـ"زجاج المحرّمات" والخوض في إشكاليات الهوية، والاحتكاك بالواقع الذي يجمع الفلسطيني والإسرائيلي معًا في حيّز مكاني واحد، واستفزازه كمحاولة للنفاذ إلى جوهره. هنا حوار معها.
- دعينا نبدأ حوارنا من قلق الجملة الأولى من الرواية؛ كيف تتعاملين معها عادةً؟ وكيف تبدئين روايتك؟
يختلف ذلك من نص إلى آخر، ولكن في العادة يكون عندي تصوّر واضح عن البداية، وأحيانًا النهاية. التفاصيل هي المقلقة بالنسبة لي. لكن عندما يأخذ النص إيقاعه وموسيقاه لاحقًا، فقد أقوم بتغيير البداية وتفاصيلها. في كلّ مرّة أعود للعمل على النص أقرأه من جديد وهذا يعني أنّني في عملية نحت دائم إلى أن أصل إلى شعور أنه أصبح سلسًا ينساب بين أصابعي كقماشة حرير على الرغم من كلّ تعقيداته.
- بدأ مشوارك الأدبي بنشر روايتك الأولى "سارق النوم: غريب حيفاوي" عام 2011. مما لا شكّ فيه أنّ هذا التاريخ هو تاريخ النشر. سؤالنا: متى بدأت ابتسام عازم الكتابة بشكلٍ فعلي؟ ما الذي جاء بها إلى عالم الرواية؟ ولماذا الرواية تحديدًا؟ نسأل طبعًا عمّن وجّه خطواتك الأولى نحو الكتابة؟ وفجّر أسئلتها لديكِ؟
لا يمكنني تحديد تاريخٍ معينٍ لبداية الكتابة. كانت عندي دائمًا محاولات، ولكن أعتقد أنّني بدأت الكتابة الإبداعية فعليًا، أو ربّما بشكلٍ جدّي، عندما تعلّمت أن أكون وأستمتع بوقتي مع نفسي. تلك الخلوة، ولم تكن وحدة، كانت مفتاحًا للذهاب في رحلات مع القراءة والتخيّل وسرد القصص التي لم تكتب دائمًا. كانت هناك محاولات دائمة للكتابة الإبداعية، لكن لم أحاول حتى نشرها لأّنها لم تكن جيدة. وفي فترة ما اعتقدت أنّه ربما من الأفضل أن أترك موضوع الكتابة الإبداعية كليًا. وقمت بمحو كلّ ما كان عندي من نصوص على حاسوبي لأنّني لم أجدها جيدة، وكنت قد يئست من ذاتي وإمكانية أن أكمل الرواية الأولى بالشكل الذي أريده. لكنّ الهاجس لم يتركني وبقيت لفترة طويلة أفكّر بتلك النصوص إلى أن وجدتُ نفسي مجدّدًا أعود إلى الكتابة ولم يكن بعدها من الممكن أن أعود أدراجي. كنت كالذي وصل إلى البر بعدما ركب البحر طويلًا. وتولّد عن ذلك "سارق النوم غريب حيفاوي" الذي صدر عن "منشورات الجمل" عام 2011، وكنت قد قطعت عقدي الثالث ببضعة سنوات قد يكون هذا تاريخ نشر متأخر للبعض، لكنّني وجدته الأنسب بالنسبة لي.
ابتسام عازم: ما جاء بي إلى عالم الرواية يصعب تفسيره، لكأنّ هناك قوة داخلية دفينة، فيها القمع والحب والقهر والعصيان والجمال والبشاعة، تحارب من أجل أن تخرج
ما جاء بي إلى عالم الرواية يصعب تفسيره، لكأنّ هناك قوة داخلية دفينة، فيها القمع والحب والقهر والعصيان والجمال والبشاعة، تحارب من أجل أن تخرج. الكتابة الإبداعية بالنسبة لي ضرورة لا يمكن أن أستغني عنها. الإبداع عمومًا، والكتابة الإبداعية تحديدًا، تجعلني أعيش حرية شبه مطلقة وإمكانية التحليق دون قيود وخوف وحدود. أدب الرواية يغريني بشدّة لأنّه مرن ويمكن التجريب فيه على عدّة مستويات كما يتحمل المزج، أكثر من غيره من الأجناس الأدبية. لكنّي شغوفة بالأجناس الأدبية الأخرى، من بينها القصّة القصيرة والمسرح، وآمل أن أنشر الكتاب القادم في الربيع وسيكون مجموعة قصصية.
اقرأ/ي أيضًا: الروائية روزا ياسين حسن: لا نجاة لنا بغير الفنّ
- شكّلت مدينة حيفا خلفيةً لروايتك الأولى "سارق النوم: غريب حيفاوي"، وحضرت كذلك شقيقتها يافا لتشكّل خلفيةً لروايتك الثانية "سفر الاختفاء". هل يُمكن أن نعتبر هذا الأمر ولعًا بالمكان؟ وإلى أي حدٍ تعوّلين عليه، المكان/ المدينة، في بناء عمارتك الروائية؟ ماذا عن التجارب الشخصية وموقعها في رواياتك؟
واحد من الأمور الرئيسة في الدعاية الصهيونية هي أنّ فلسطين كانت أرض صحراء دون حضارة متطورة، وأنّهم قاموا بإعمارها، وما إلى ذلك من دعايات استعمارية. طبعًا هناك إشكالية أخرى متعلقة بالنظرة الاستشراقية إلى الصحراء وكأنّها ليست مكانًا منتجًا للحضارة، وهي نظرة غير صحيحة وإشكالية ولكن لهذا حديث آخر، ما يهمني هنا أنّ فلسطين قبل نكبتها عرفت وكان فيها أكثر من عشر مدن متطورة، اقتصاديًا وثقافيًا ذات عمق تاريخي. عرفت مجتمعاتها حياة مدينية غنية ومتنوعة، ناهيك عن قراها ومناطقها البدوية. وعندما يتم تناول هذه المدن اليوم، خاصة مدن الساحل في فلسطين التاريخية كيافا وحيفا وغيرها، فإنّ الحديث عن الحياة هناك فيه الكثير من التعميم والتهميش بوصفها غيتوهات أو بؤر للفقر والهامش، إلا أنّ تلك القراءة غير دقيقة، في أحسن الأحوال، وهي تأخذ دائمًا الفلسطيني وحياته في مقاربة مع يهود أوروبا. هذا لا يعني أنّها غير مهمّشة أو فقيرة ولكنّها ليست الهامش أو الغيتو الأوروبي. وهنا يقع الخطأ الأكبر لأنه يجاري، بحسن نية في الغالب، المرجعية الاستعمارية والرواية الإسرائيلية.
المناطق "المهمّشة" أو الـ"غيتوهات"، على الرغم من تحفظاتي على التسميات، هي لبّ المجتمع الفلسطيني وأغلبيته وهي المركز ولكن علاقتها مع جنوب أفريقيا مثلًا أقرب من أوروبا. وعلينا إعادة تعريف معنى "الهامش" والـ"غيتو" والتوقف عن استخدام المرجعية الغربية الصهيونية (اليهودية الأوروبية) للحكم على محيطنا وعلى فلسطين والفلسطينيين في المنفى. كما علينا أن نتعامل مع التاريخ اليهودي العربي (واليهودي الفلسطيني قبل الصهيونية) بعيدًا عن المركزية الصهيونية الغربية، وهذا أمر معقد جدًا وله حديث آخر كذلك.
أحاول أن أحرّر نفسي من الفكر الاستعماري الذي تربيت في ظله (مدارس وجامعات). هذه عملية ليست سهلة ودون شك أقع في الفخ في أكثر من مناسبة. بالنسبة لي، علينا كفلسطينيين، أو مؤيدين وعاملين في فضاءات القضية الفلسطينية ومؤمنين بعدالتها، سواء كنا أدباء أو باحثين أو صحفيين.. إلخ، أن ننظر إلى السياق الفلسطيني وخصوصيته التي لا تشبه أي وضع آخر. وهنا لا أتحدث عن استثناء فلسطيني لأنّه لا يوجد استثناء لأي قضية، بل توجد خصوصية لكلّ حدث وقضية عالمية ومن بينها القضية الفلسطينية. صحيح أنّه يجب أن نرى فلسطين وما يحدث فيها في سياق استعمار استيطاني، ولكن حتّى هذا السياق لا يوجد فيه نوع واحد فقط من الاستعمار الاستيطاني. من الضروري بالنسبة لي أن أطوّر أدواتي وأتحرّر من المركزية الأوروبية وهذا ليس سهلًا بتاتًا، لشخص مثلي درس في مدارس عربية ولكن وضعت مناهجها السلطات الإسرائيلية، كما أنّ كلّ الجامعات التي درست بها، الجامعة العبرية في القدس، وجامعة فرايبورغ في ألمانيا وجامعة نيويورك في الولايات المتحدة، جامعات غربية تعتمد في مناهجها على مركزية المعرفة الأوروبية/ الغربية. عملية التحرّر المستمرّة بدأت بسن صغيرة، واستيعاب الطفلة الصغيرة التي كنتها أنّ ما نتعلمه في المدرسة من تاريخ وأدب وجغرافيا وأسماء جميعها تختلف تمامًا عمّا أسمعه في البيت والشارع. هناك ضرورة بالنسبة لي كروائية أن أقرأ ما أراه في الواقع الفلسطيني دون الحكم سلبًا أو إيجابًا وأدلجة ما أراه ومحاولة استيعابه بتعقيداته دون تأطيره ومن ثم وضعه في قراءات روائية سلسة داخل النص قدر الإمكان.
ابتسام عازم: ما حدث مع النكبة أكثر من تطهير عرقي وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية عن بكرة أبيها وتدمير المدن الفلسطينية
في الرواية الأولى، أو النوفيلا، حيث أعتبر "سارق النوم غريب حيفاوي" نوفيلا أكثر مما هي رواية، تشكّل أكثر من مدينة، وليس حيفا وحدها، مسرحًا لأحداثه، بل إنّه من غير الواضح في بعض الفصول أين تدور الأحداث. لكنّها دون شك تدور في الحيز "المديني" المشوّه بما فيه القدس وحيفا، ويافا. لكنّ هذا الحيز هو بين "حيزين"، أي أنّ هذه المدن المنكوبة التي نجت لم تعد تشبه ذاتها ولا هي شيء آخر "جديد" ممسوح الذاكرة، كما أرادت لها المؤسسة الصهيونية الممثلة رسميًا بإسرائيل. ما حدث مع النكبة أكثر من "مجرد" تطهير عرقي وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية عن بكرة أبيها وتدمير المدن الفلسطينية. ما حدث هو عملية ممنهجة ومستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني القروي والبدوي والمديني في فلسطين. إنّ ملاحقة الفلسطينيين في كلّ مكان يوجدون فيه، حتّى يومنا هذا، وارتكاب المجازر ضدهم والتمييز ومحاولة طمس حكاياتهم لهي أمثلة بسيطة على ذلك. كلّ هذا يشكل هاجسًا وهوسًا في محاولة للإمساك بحيز مديني يجهله ويتجاهله كثيرون. نخطئ إن حصرنا ما أكتب في حيز يافا، فيافا رمز للمخيم والقرية قبل أن تكون رمزًا للمدينة فقط.

لم أولد في مدينة لكنّ المدينة، يافا تحديدًا، ولدت داخلي. وجاء هذا بسبب تأثير جدتي لأمي في تربيتي. إذ ولدت وتربت في يافا ولكنها تهجّرت أثناء النكبة داخل فلسطين لتصحو بين ليلة وضحاها وترى بلدا كاملًا يسمونه باسم جديد. هل يمكن أن ينسى الإنسان اسمه الأول؟ أنا ولدت في بلدة لا هي قرية ولا مدينة. أهلها لم يعودوا فلاحين ولم يصبحوا عمالًا.. دمّر الاستعمار الإسرائيلي القرية والمدينة الفلسطينية وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1948، فأصبحت أماكن سكننا، في المدن والقرى، مجرد أماكن للنوم، الهدف من إبقائها هو خدمة المستعمر والعمل في مستعمراته ومن أجلها. لم يتغير الوضع كثيرًا في عمقه وإن لبس الاستعمار أثوابًا وأقنعة أخرى. لكن من الضروري بالنسبة لي ألّا يتم النظر للداخل الفلسطيني كاستثناء أو كمنسلخ عن بقية أماكن تواجد الفلسطينيين في المنافي أو بقية فلسطين المحتلة عام 1967.
- هل من الممكن اعتبار روايتك الأولى، ومن بعدها الثانية، مسودّة لمدونة المدينة؟ نقصد أنّ حيفا ويافا، هل تحتاجان اليوم إلى كتابة ثانية نظرًا لتراكم الوقائع المهملة هناك؟ وهل يُمكن القول بأنّ رواياتك فعلت ذلك؟
أعتقد أنّني أجبت على الشق الأول من سؤالك في الجواب السابق. أما فيما يخص الشق الثاني فأتمنى أن تكون رواياتي قد فعلت ذلك ولو بشكل جزئي. ما أكتبه هو جزء من فسيفساء ضخمة للأدب والإبداع الفلسطيني والعربي، كما من الضروري ألّا ننظر للأدب بأنواعه على أنه بمعزل عن المشهد الموسيقي والسينمائي والفني وغيرها مما يحدث على الساحة الفلسطينية والعربية. الأدب والرواية تحديدًا في حوار دائم مع الأجناس الأخرى.
- يُقال أنّ ابتسام عازم في روايتها "سارق النوم" أطّرت نسخة خاصّة جدًا من الإنسان اللاجئ داخل ذاته، لا خارجها، وكذلك لنمط فريد من الفلسطينيين، لا هو بارز تمامًا، ولا هو ممحو كليًا. ما رأيك؟ وكيف تفسّرين الأمر؟
أعتقد أنّ في هذه المقولة شيئًا من الصحة. هناك قمع للفلسطينيين يظهر للعين يمكن تصويره وتوثيقه، ولكن هناك قهرًا وغضبًا وقمعًا على مستوى آخر وإضافي تتمّ معايشته ولا يمكن التعبير عنه إلا إبداعيًا بالنسبة لي على الأقل. أتذكّر موقفًا عنصريًا، من مئات المواقف، حدث معي أثناء معيشتي في القدس. لن أطيل في سرد تفاصيل الموقف، حيث كتبت عنه قصة قصيرة لم تنشر بعد، ولكن ما حدث أنه وأثناء ركوبي الحافلة من القدس إلى يافا قام شخص عنصري بشتمي والصراخ بأنني "عربية قذرة"، نعم "عربية قذرة" قال للركاب "انظروا إليها انظروا إلى هذه العربية القذرة!" ما زالت كلماته ترن في أذني. كنت في الثامنة عشرة من عمري، وكنت أقرأ كتابًا بالعربية وسألني لماذا أقرأ شيئًا بالعربية معتقدًا أنني يهودية. وعندما قلت له أنني من هنا وأنني فلسطينية، وقف وسط الحافلة ولم يتوقف عن شتمي لنصف ساعة. لم يتدخل أحد من الركاب الأخرين الذين كانوا إسرائيليين، ولا أدري إن كان هناك فلسطيني آخر في الحافلة لم يتدخل كذلك من الخوف. بل إن أحد الركاب كان يضحك على الموقف. لك أن تتخيل كمية الرعب وأنا محبوسة في ذلك الباص وذلك الشخص يصرخ ويشير إليّ. ما شعرته من مرارة، وأنا داخل وطني، من الصعب وصفه كان خليطًا من الخجل والشلل والقهر والذل ناهيك عن التهديد الجسدي الذي شعرت به كامرأة وليس فقط كفلسطينية. هذا موقف من مواقف كثيرة وقصص لا يمكنني إلا التعبير عنها إبداعيًا. هناك صمت شديد في داخلي ربما ورثته عن جدي لأمي، الذي كان شديد الصمت فيما يخص النكبة أو الماضي. هذا الصمت ورثته وعشته وعنه أحاول الكتابة من ضمن ما أكتب، على عكس جدي أنا قررت أن أتحدث وأنشر ولو قليلًا.
ابتسام عازم: هناك محاولات قوية لتشويه ما حدث في فلسطين، ليس فقط من قبل الاحتلال نفسه، بل كذلك من قبل غربيين أو عرب مناصرين للاحتلال
- لنتوقّف عند "نمط فريد من الفلسطينيين لا هو بارز تمامًا، ولا هو ممحو كليًا"؛ هل كان هذا الالتباس في "سارق النوم" تمهيدًا لاختفاء الفلسطينيين في "سفر الاختفاء"؟
فكرة الاختفاء جاءت صدفة وبعد نشر "سارق النوم" بأشهر. لا شكّ أنّ غريب حيفاوي، الشخصية الرئيسية في "سارق النوم غريب حيفاوي" هو شخص أكثر تردّدًا من علاء في "سفر الاختفاء". لكن الأمر يعود كذلك للمرحلة العمرية لكلّ منهما والتجربة في الحياة. ما يعيشه غريب في "سارق النوم" ليس التباسًا بقدر ما هو محاولة للتعامل مع كلّ التناقضات التي يفرضها العيش تحت استعمار استيطاني، وعدم وجود قيادات أو أيقونات من حوله حيث قتل أو نفى الإسرائيليون أي قيادات فلسطينية ثقافية أو سياسية، في الداخل والمنفى، كانت تشكّل علامات فارقة. بحيث أصبحنا أجيالًا دون آباء أو أمهات.
اقرأ/ي أيضًا: مها حسن: لا أكتب سيرتي الشخصية في رواياتي
إذًا هي محاولة للتصالح مع هذه التوتر المستمر مع اليتم الذي يعيشه جيل أو أجيال كاملة. في "سفر الاختفاء" يشعر علاء بتصالح أكثر مع ذاته ولا يرهقه التوتّر أو "اليتم". ولعلّه بمكان ما يريحه ويتوقف كذلك عن التعامل مع المستعمر وقصّته كمرجعية أو مقارنة. الصورة واضحة بالنسبة له ومسألة الانفجار مسألة وقت لا أكثر.
- نقرأ في "سفر الاختفاء" التالي: "لعلّني أكتب خوفًا من النسيان، أكتب لأتذكّر وأذكّر خوفًا من أن تُمحى الذاكرة من الذاكرة، كأنّ الذاكرة حبل نجاتي الأخير". هل يعني ذلك أنّ ابتسام عازم تكتب خوفًا من أن تنسى وأن ينسى الآخرون كذلك؟ ولماذا تكون الذاكرة حبل النجاة الأخير؟ ما السبب؟
سأبدأ من الجزء الأخير في سؤالك، أي السبب وراء كون الذاكرة حبل النجاة الأخير. يحاول الإسرائيليون، وهذا ينطبق على أي بلد استعماري كالولايات المتحدة، ومجتمع الأغلبية هناك، أي البيض الأوروبيين، وغيرها، يحاولون الحديث دائمًا عن "المستقبل" والنظر إلى الأمام وعدم الالتفات للماضي مدعين أنّ النظر إلى الماضي والنبش به سيعيدنا إلى الوراء ويكبلنا.. إلخ. هناك محاولات قوية لتشويه ما حدث في فلسطين ليس فقط من قبل الاحتلال نفسه بل كذلك من قبل غربيين أو عرب مناصرين للاحتلال أو كما يصفهم فانون، أصحاب العقول المستعمَرة. وهناك فئة أخرى جاهلة أو تتجاهل ما يحدث. وعلى الرغم من إيماني أنّ التركيز على الماضي فقط فيه إشكالية إلّا أنّ محوه والتعامل مع الحاضر وكأنّ لا علاقة له بالماضي لهو أكثر إشكالية. عندما نتحدث عن الذاكرة وعمّن يرسم تلك الذاكرة ويكتبها فإننا نتحدث عن الكيفية التي نريد أن نرسم بها المستقبل.
- في الرواية نفسها، يُخاطب علاء، بطل الرواية، جدّته تحديدًا، ونعرف أنّ والده مات منتحرًا، وأنّ والد شريكه في السكن، أريئيل، لقي مصرعه بانفجار مروحيته في سماء لبنان. لماذا يغيب الوالدان وجيلهم لصالح جيلٍ سبقهم وآخر جاء بعدهم؟ وهل من سرٍّ ما في أن يكون والدا علاء وأريئيل ميّتين؟
لا توجد مرايا هنا بل توجد علاقات قوة متحركة. انتحار والد علاء هو رمزي، كما تناولت الإجابة أعلاه، لموت جيل كامل ورموزه بسبب قتلهم أو عجزهم. كما أنّ له رمزية إضافية منها وحدة الناجين، وعبء الصدمة وغيرها. فيما يخص إريئيل، فإن موت والده الطيار جاء أكثر لترسيخ صورة الصهيوني الليبرالي الذي ضحى من وجهة نظر مجتمعه.
- يطرح علاء سؤالا جوهريًا في "سفر الاختفاء"، وهو: "كيف لي أن أكنّس ذاكرتهم من ذاكرتي؟". ويبدو، في مكانٍ ما، أنّ هذا السؤال هو واحد من أساسات الرواية. سؤالنا: هل يبدو الأمر صعبًا إلى هذه الدرجة؟ وهل يمكن أن نعتبر أنّ هذا السؤال، هو ما يشغل ابتسام عازم أدبيًا؟
ليس الأمر صعبًا بقدر ما هو محاولة لشخص يعيش تحت الاستعمار بأن يتحدّث عن مصيره ويراه دون أن يربطه بمصير "الآخر". إذًا، تكنيس "ذاكرتهم من ذاكرتي" هي عبارة عن الخطوة الأولى في علمية التحرر. وهذا ليس بتلك السهولة التي قد نتصورها. هو نوع من إعادة ترتيب العلاقة بالحيز العام والمكان المستعمر حتى مع مدن كتل أبيب، وهذه أمكنة أصبحت فيها ذاكرة/ ذكريات أخرى. هي نوع من إعادة ترتيب المعنى والعلاقة بالمكان وبالذاكرة، بوطن اسمه فلسطين ومحاولة الإمساك به من جديد وترتيب جغرافيته المتحركة.
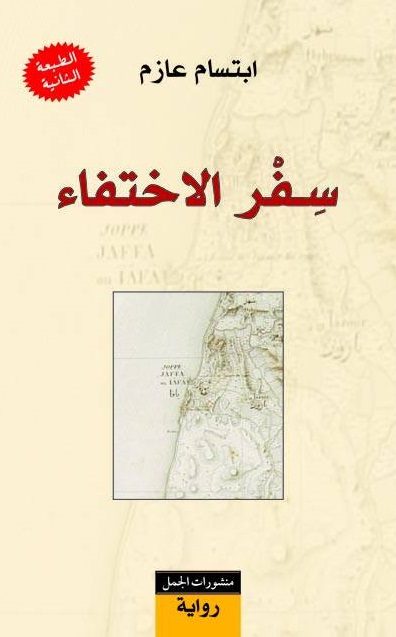
- كيف تفسّرين لنا أن يكون وجود الفلسطينيين كابوسًا بالنسبة للإسرائيليين، وأن يكون غيابهم كذلك كابوسًا اشدّ من الأول؟ هل نفهم أنّ الإسرائيليين بحاجة إلى الفلسطينيين لإدراك أو للانتباه إلى وجودهم؟
وجود الفلسطينيين كابوس لأنّه يذكرهم بما ارتكبت أيديهم أو أيدي أجدادهم واستمرارهم بالاستفادة منه وممارسته بطرق مختلفة فالنكبة الفلسطينية لم تنته. ولعلّ أجمل ما يلخّص ذلك قول محمود درويش "خوف الغزاة من الذكريات". أمّا الخوف من غياب الفلسطينيين، والذي تتناوله رواية "سفر الاختفاء"، فهو نابع من عدّة أمور، منها أنّ المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى "البعبع" الفلسطيني كي يستمر "سلامه" الداخلي. لكن من الضروري رؤية الرواية في سياقات أبعد من الاختفاء الذي له معاني ومستويات عديدة، أي إلى إعادة تشكيل المكان/ والزمان.
- هل نستطيع القول إنّ ابتسام عازم تكتب عن حاضر لا نعرفه من جهة، وواقع مطوّق أو معزول من جهةٍ أخرى؟ وكيف يمكن للقارئ أن يتعامل مع مقولة علاء هذه: "تعبت ولا أريد أن أثبت وجودي، لأنّني بساطة موجود"؟ لربّما القارئ الإسرائيلي تحديدًا؟
واحدة من الإشكاليات الكبيرة بالنسبة لي فيما يتعلّق بفلسطين والفلسطينيين، هو أنّ قضيتنا يتمّ تداولها بشكلٍ دائم في الأخبار. قد يكون للأسباب الخطأ التي لا علاقة لها دائمًا بنا بل بالإسرائيليين. قراءة تلك المقولة فيها عدّة مستويات، أولًا أنّ علاء في الرواية لم يعد يرى حاجة أو رغبة بإقناع المستعمر بوجهة نظره. هو وصل لنقطة أدرك فيها أنّ هذا "الإقناع" في الوقت الحالي ما هو إلا وسيلة لإطالة عمر استعماره. لكنّ تلك الجملة لها دلالات داخلية فلسطينية وعربية كذلك. كما أنّه يقف في تلك الجملة عند مفترق طرق يدرك من خلاله وحدته كفلسطيني في وطنه تحت علم دولة ليست دولته ولم تكن ولن تكون كذلك.
ابتسام عازم: وجود الفلسطينيين كابوس لأنّه يذكّر الإسرائيليين بما ارتكبت أيديهم أو أيدي أجدادهم
- في النهاية، نودّ سؤالك عن جديدك، وعمّا يشغلك أيضًا، أدبيًا، في الوقت الحالي؟
كتبت عددًا من القصص القصيرة التي نشرت في مجلات مختلفة. وهناك قصص أخرى ما زلت أعمل عليها ولم تنشر بعد وأتمنّى أن أتمكن من إنهائها ونشرها كمجموعة قصصية في الربيع القادم. هناك مشروع رواية ثالث أعمل عليه منذ سنوات. وهي مستوحاة من قصة عائلة يافاوية، ما زالت تعيش في يافا وتملك واحدة من البيارات الأخيرة في المدينة، وإن كانت الأشجار قد اقتلعت كلّها، وقتل أغلب الرجال الذين نجوا من النكبة على مرّ السنوات حتى التسعينيات. تدخل الرواية كذلك إلى عوالم المخدّرات وبلدات أخرى غير يافا. أجريت مقابلات مع نساء في العائلة، حيث تربطيني بهم علاقات عائلية. لكن كتابة الرواية منهكة وتحتاج الكثير من البحث والعودة للأرشيف بما فيها الصحف. ولأنّني وللأسف غير متفرّغة بشكلٍ كامل للكتابة الإبداعية وطبيعية عملي حاليًا كمراسلة وصحفية لا تسمح بإجازات طويلة، احتاجها لإنهاء الأجزاء الدسمة من الرواية، فإنّ الكتابة تسير بشكلٍ بطيء... لكنها تسير.


